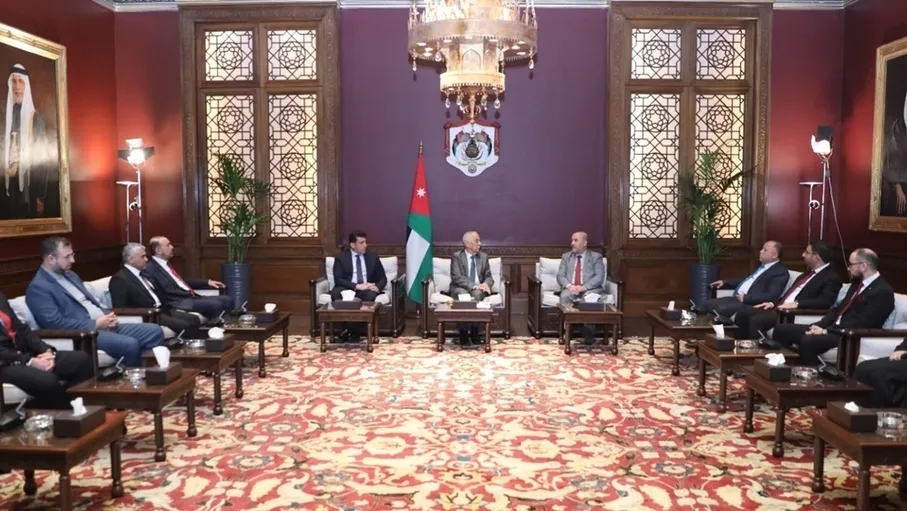لماذا يعجبون بمسؤولي الغرب؟!

يشارك كثير من الأردنيين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو لمسؤولين غربيين بحسرة ووجع، يعبران عن عدم رضاهم عن مسؤولينا، مع أمنيات بأن يتحقق للمواطن ما توفر في العالم الغربي.
مما يتداوله الأردنيون، صورة رئيس وزراء أجنبي يقود دراجة هوائية، أو نظيره في بلد غربي آخر يبرر للجمهور كيف سدد تكلفة آلة لصناعة القهوة موجودة في مكتبه.
والجمهور الأردني تستهويه، أيضاً، صورة لمسؤولة شابة تتبوأ واحداً من أعلى وأهم المواقع في بلاد الغرب، فلم تمنعها من ذلك جذورها العربية ولا كونها مسلمة؛ إذ استطاعت أن تستثمر فرصتها العادلة وسط تنافس حقيقي، فنالت مكانتها اعتمادا على مؤهلاتها وليس بواسطة ثقيلة العيار!
كل الصور وما يرافقها من تعليقات، تعبر عن إحباط المجتمع من المسؤولين لدينا، وفقدان الثقة بهم، وبما يمثل عنواناً لحالنا العامة السيئة.
فاليوم، تعد أزمة الثقة هي الأخطر في بلدنا. ويمكن القول بجرأة، إن الكل لا يثق بالآخر، والمؤسسات تعمل ضمن علاقات تنافس لا تكامل، بما ينعكس بالنتيجة على سير الأمور، ويعقّد القدرة على اتخاذ القرار، ويوفر بالتالي سببا إضافيا لعدم رضا المجتمعات عن أحوالها، بما يشبه الدوران في حلقة مفرغة!
خيبات الأمل من الحكومات، وضمن ذلك خططها النظرية التي فشلت في خلق نموذج اقتصادي أردني ناجح حتى الآن، وتنصل هذه الحكومات من مسؤولياتها ووعودها، تتسبب بمزاج سيئ تجاه من يصنعون القرار، وسط حالة من التشكيك بما يقومون به.
الحال زادت سوءا لدرجة طغى الرفض لكل ما هو رسمي. وإثارة الظنون المرتابة لطالما كانت حاضرة في جميع الملفات، بحيث تطفو على السطح مع كل أزمة أو قصة نظريات المؤامرة التي تحاول إحباط كل تقدم.
الفجوة بين العملي في أداء حكوماتنا، والنظري المتمثل في الوعود التي قُدمت مع كل خطاب حكومي في الرد على التكليف الملكي، جعلت الناس يكفرون بمسؤولي البلد. وعمّق ذلك تعقد الظروف الاقتصادية وصعوباتها.
نمط الإنفاق لدى بعض المسؤولين كان أحد أسباب التعلق بمسؤولين أجانب يبدون كأنهم ينتمون إلى "العالم الآخر" في كوكب قصيّ! فصار نموذج هؤلاء المسؤولين الغربيين وسبل تعاطيهم مع مجتمعهم وكل مشاكله، حلماًَ وأمنية بأن يوجد مثلهم في حياة الناس لدينا.
مواجهة هذا الواقع السلبي الخطير ليست صعبة، إذ هي تكمن فقط في تطبيق مبدأ متداول لدينا، نظرياً على الأقل، مضمونه أن العمل العام في مختلف السلطات؛ لاسيما التنفيذية والتشريعية، تكليف لا تشريف. وأيضا، تطبيق مبدأ رئيس واحد، جوهره الابتعاد عن البحث عن المنافع الشخصية، والجري -كما هو مفترض- خلف المصلحة العامة، لسد أيّ باب لشبهات فساد، وذلك من حقيقة أنّ أكثر ما يغضب الأردنيين هو التعدي على المال العام.
في البال، وأنا استعرض أحوال مسؤولينا، نماذج إيجابية يفرض الإنصاف الإشارة إليها. فأحدهم كان يرفض السفر عبر الصالة الخاصة في المطار، ويفضل السفر على الدرجة السياحية (إكونومي). وآخر اشترى آلة صناعة القهوة على حسابه الشخصي. وثالث رفض استخدام السيارة الرسمية التي تتوفر له بموجب الموقع.
أمثال هؤلاء موجودون بيننا، لكنّ أثرهم ظل محدودا في تغيير الصورة السيئة المرسومة للمسؤول في ذهن المواطن؛ ربما لأن السلبي عادة ما يطغى على الإيجابي والكثير على القليل، كما أن ممارسات بعض المسؤولين هشّمت صورة البقية في وجدان الأردني.
أوجاع المواطن من المسؤولين قصة تكتب. وهي توصلنا إلى أن تراجع مواصفات النخب لدينا حدث بعد تعطل آليات تجديدها. وقد بات البلد في أمسّ الحاجة إلى إعادة تفعيل هذه الآليات وتجديدها، حتى نستعيد الثقة بالمسؤول، فيقلّ حتماً إعجابنا بمسؤولين من بلد آخر، لا نرى نظراء لهم لدينا، فيما نغرق في وعود خطاب رسمي لا يُترجم ممارسة فعلية تخفف من صعوبات واقع الأردنيين.