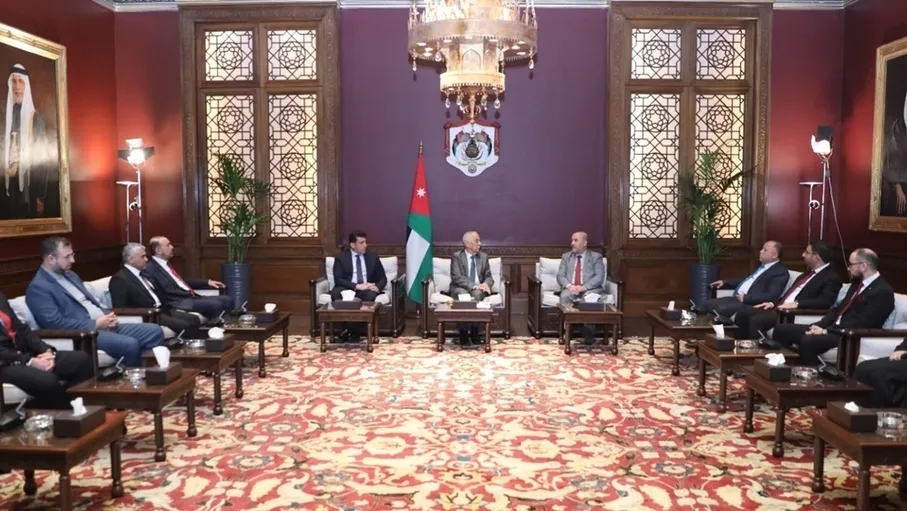الكتب المعارة: جلساؤنا الذين يخرجون ولا يعودون..!

من الوفاء لحب المعرفة أن لا يضنَّ المرء بكتبه على المعارف والأصدقاء. وفي أغلب الأحيان، يحرص المستعير على تأكيد أنه ممن يردُّون الدَّين ويعيدون الكتب. ويؤكد صاحب الكتاب غالباً أنه يقدم كتابه على سبيل الإعارة ويرغب في استعادته لدى الانتهاء من قراءته. لكنَّ الذي يحصل في أغلب الأحيان، أن الكتب المعارة تصبح "دَيناً ميتاً"، وتخرج من مكانها على الرفِّ في رحلة هي الأخيرة التي بلا عودة.
بعض الناس يستشهدون بالعبارة الشائعة: "مجنونٌ مَن يعير كتاباً، والأكثر جنوناً من يردُّه لصاحبه". وفي الغالب، ينصب التركيز على الجزء الثاني الخاص بالمستعير، والمترتب منطقياً على تحقُّق الجزء الأول. فلولا جنون المعير، لما كان ثمة حاجة إلى "عقلانية" المستعير. لكنَّ لإعارة الكتب مبرراتها التي لا تتصل بالجنون، وليس أقلها الرغبة في الإفادة، والمودَّة، وكسرُ جليد العلاقات. وفي بعض الأحيان، يشتهي المرء لأحبابه قراءة كتاب أعجبه، مثلما يشتهي لهم طعاماً أحبَّه.
تروح السَّكرة وتأتي الفكرة، عندما يحتاج صاحب الكتاب كتابه للإحالة إليه في بحث، أو حتى لمجرد التسلِّي في عطلة. وعلى سبيل المثال، ذكّرتني ذكرى وفاة الروائي العظيم عبد الرحمن منيف، بخماسيته الرائعة "مدن الملح"، وأحببت أن أعاود قراءة جزئها الأول الأكثر براعة "التيه". لكنني اكتشفتُ أنه لم يعد لديَّ حتى جزءٌ واحد من الخمسة. ولا أعرف من هو الذي (أو الذين) استعاروها ولم يعيدوها. وبالمناسبة، أحببتُ دائماً معاودة قراءة هذا الجزء كلما جاء الحديث إلى قصة النفط، وما حصل ويحصُل للمنطقة بسبب اكتشافه في مناطقنا. وأتصوَّر أن "التيه" تبيِّن بطريقة منقطعة النظير بداية الرحلة الصعبة إلى ما نحن فيه.
في إحدى المرّات، صنعتُ ختماً مطاطياً وطبعتُه على كتبي. كان الختم عبارة عن رسم للصَّ يضع عصابة مثقوبة عند العينين على رأسه وينسل من باب موارب وعلى ظهره كيس. وعلى الختم، كتابة: "هذا الكتاب مسروق من..."! وتصورتُ أن الذي يستعير كتبي ربما يتأثر بالرسم ويتذكر الاسم، فيقرر أن يعيد ما استعار. والنتيجة، هي أنني أتخيَّل الآن شكل ذلك الختم من الذاكرة، لأنه لم يعد لدي كتاب واحد على الأغلب من تلك الكتب الممهورة به. وفي الحقيقة، أستطيع أن أتذكر بعض كتبي ومن هم الذين استعاروها، لكنني أخجل من طلبها خوفاً من إحراج المستعير العزيز بالتأكيد، والذي ربما تصرف بها أو أعارها بدوره.
للأمانة، قلّ أن ينجو محبٌّ للكتب من اقتناء كُتبٍ استعارها ولَم يُعدها أيضاً –ولستُ استثناءً. ولذلك، يعاني هؤلاء جميعاً من هذه الظاهرة التي تبدو جزءا لا بد منه من العلاقة مع الكتب. وقد يُخيَّل لأحد أن المسألة تتعلق بقيمة الكتاب الماديّة (ثمنه)، لكنَّ هذا غالباً ما يكون آخر الهموم. فهناك ما ذكرته آنفاً عن الحاجة إلى كتاب مخصوص في لحظة مخصوصة. وفي هذه الجزئية، هناك كتُبٌ يكاد يستحيل العثور عليها في السوق، لأن طبعاتها نفدت أو أنها جُلبت من أماكن أو في ظروف معينة؛ وهناك الكتب الممنوعة أو النادرة، أو ذات الطبعات المحدودة، وهكذا.
وهناك أيضاً كتُب لها مكانة خاصة، بهيئتها وما هي عليه، مثل كتاب عليه إهداء موقع من المؤلف؛ أو كتابٌ كان هديَّة من عزيز؛ أو آخر مرتبطٌ بذكرى، أو فيه ملاحظات خُطت بقلم الرصاص على الهوامش والحواشي. وفي بعض الأحيان، تكون الطبعات القديمة أجود طباعة وإخراجاً من الجديدة. وفي أحيانٍ أخرى، تتعلق المسألة بمزاج صاحب الكتب. وعلى سبيل المثال، قد لا يحبُّ المرء أعمال الكاتب الكاملة في مجلد جديد أنيق، وإنما يحبُّ طبعات كتبه المنفردة القديمة، بورقها المصفرِّ والبلى في أطرافها، وبالهيئة التي قرأها بها أول مرَّة وصنع معها الإلفة.
على كل حال، قد تكون هناك فائدة في عدم استعادة الكتب المعارَة، لمصلحة الحيِّز أو إحلال كتب جديدة. أو يقترح البعض أن الكتب أصبحت متاحة على "الإنترنت" بحيث يكون اقتناؤها ورقياً لزوماً لما لا يلزم. لكنَّ الشعور يظل سيئاً عندما يفتقد المرء جلساءه القدامى، ثم صحبهم أحد لمشوار قصير، لكنهم لم يعودوا! أو بالمثل الفرنسي المشهور "أعطني اليد التي تعير كتابا لأقطعها".