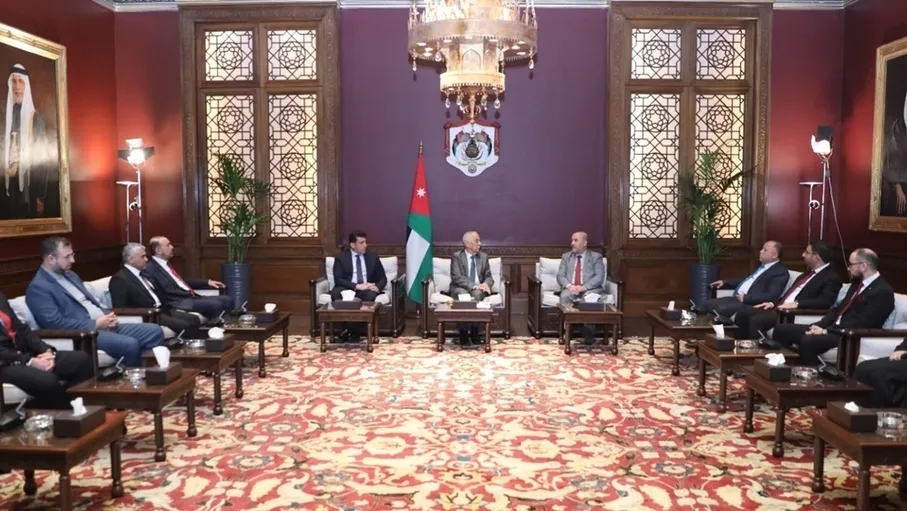كاظم وصدام.. وعقال الرأس

“لم أتقابل مع صدّام حسين رحمه الله طوال حياتي”، هذه جملة وردتْ في حوار بعد عام من حادثة “إعدام الأضحى”، في صحيفة سعودية، وكان حواراً فريداً مع المطرب العراقيِّ الأبرز كاظم الساهر، كان يردُّ على سؤال بالنفي أنه كان مقرباً من الرئيس العراقيِّ الراحل، لكن كلمتي “رحمه الله”، لم تأخذا هنا طابعاً إنسانياً دارجاً بأنَّ الميّت لا تجوز عليه سوى الرحمة، إنّما كان بقصد وإصرار، يورد في عبارة قصيرة نفيَيْن متناقضين، أشبه بكلمة “لعَمْ”!
ثمة بدايات كثيرة قبل هذه النهاية، بين أكثر زعيم إشكاليٍّ، وسادس أشهر مطرب عالمي.
كان “كاظم” مغموراً عندما استلم “صدام” الحكم، مجرّد عضو في كورال المسرح العسكريِّ، يفشل بالاختبارات الفنيّة لمظهره الرثِّ، ويغنّي في المطاعم والأعراس بديلاً إذا غاب المطرب الأول، وبعد سنوات لما يُعرف على مستوى محيطه الفنيّ، يصبح سخرية بين كبار الفنانين، لغنائه الرومانتيكيِّ الشديد الكآبة.
يغنّي أغنيات تعبوية في ذروة الحرب مع إيران، قبل أنْ يحدِّد موعد انطلاقته في نهاية الثمانينيات، ويُفتح له “باب الكويت”، ويغلق، ثمّ يفتح ألف باب لـ”الرزق” والشهرة.
كان القرار العراقيُّ عقب الهزيمة في حرب الخليج الثانية، دَعْما لـ”الساهر” الذي كانت علامات نجوميته تبرز بشكل خاص في بلاد الشام، بوصفه “حليم العراق”، وإنْ كان ظهور العندليب الأسمر ارتبط في خمسينيات القرن الماضي بـ”ثورة يوليو”، فاعتبر صوتها الغنائي، فإنّ المهمّة التي تبدو رسميّة، أن يكون “كاظم” صوت العراق في الحصار، وكانت أغنية “آه يا عرب”، المكتوبة بالمظلوميّة البعثيّة، أول رسالة مسموعة. عمّان، بيروت، ثمّ دمشق، حيث القطب البعثيُّ المعادي، فانتشرت إشاعة أن “كاظم” غنّى لـ”حافظ الأسد”، فنفاها على تلفزيون الشباب بملامح مرتبكة.
ليست تلك الإشاعة الوحيدة، التي طاردت من سيحمل بقرار وزارة الإعلام لقب “سفير الأغنية العراقية”، فالعداوات من مطربي جيله وُضعت في حكايات ووشايات، وتذمّر معلن، حتى إنّ مطرباً مخضرماً قال إن “الساهر” كان مقرراً “بعد القرآن وقبل القرآن”، أي أنّ غناءه يبدأ بافتتاح البثِّ التلفزيوني حتى الختام. وكانت نتائج التعويل على ابن الموصل بدأت بأن فتح الخليجُ بعض شواطئه، فغنّى أولاً في “الدوحة” في العام الخامس من التسعينيات، ثمّ في “دبي” في العام السادس. كسر “كاظم” الحصار، حتى وصل القاهرة، وعلى مسرح الأوبرا العريق سجدَ شاكراً.
في الحوار الفريد، يصف “كاظم” نجل “صدّام” بأنّه كان “صديقه”. ويقصد “عدي”، الذي شُرّحت شخصيته المركّبة في الكتب والأفلام الوثائقيّة، فهو “مضطرب” و”شديد الغيرة”، وكان “سَمْن” عدي على “عسل” كاظم، مرحلة اضطرارية للدور الذي أنيط بالأخير، وربّما هذا ما أخّر “الصدام” حتى العام السادس من التسعينيات. غيرة عدي من شهرة كاظم، لم تعد سراً، وحبّ النساء لـ”أبو جواد”، كان مبرراً لعدي أن يرسل من يرمي رصاصات طائشة على سيارة “الساهر” على طريق بغداد-عمّان، وفي العام التالي، في موعد عودة كاظم في نيسان بعيد ميلاد “القائد”، أرسل عدي وراءه ليغنّي في حفلة خاصة، وفي الصباح غادر كاظم العراق بلا عودة، وأطلق أغنيته المحفوظة في خزانته الموسيقية “أنا وليلى”، برموزها.
قصصٌ كثيرة أثيرت عن تلك الليلة، منها “النزول إلى المسبح بالبدلة البيضاء”، وأكثرها رواجاً التوقيع على الحذاء، لكن الساهر نفسه سيقر بعد عشر سنوات أنه “حدث شيء”، وقرر المغادرة لحبّه للحرية.
سيقتلُ “عدي”، وتسقط بغداد، وتمثال صدام في “الفردوس”، ويبدأ الفنانون والرياضيون باستعادة الشريط الأسود، لكنّ أعتى المبتلين بدودة البحث والتحرّي لن يجدوا كلمة واحدة خرجت من فم “كاظم” تشمت بـ”عدي”، بل سيكمل الساهر الصورة التي لم تلتقط مع الرئيس، وبقيت ربع قرن متروكة للتكهنات، حين يصرّ بأنّه لم يغنّ لصدام رغماً عنه، ثمّ يُفسّر عدم اقترابه من حكّام العراق الجديد، بأنّه الوفاء لـ”عقال الراس”.