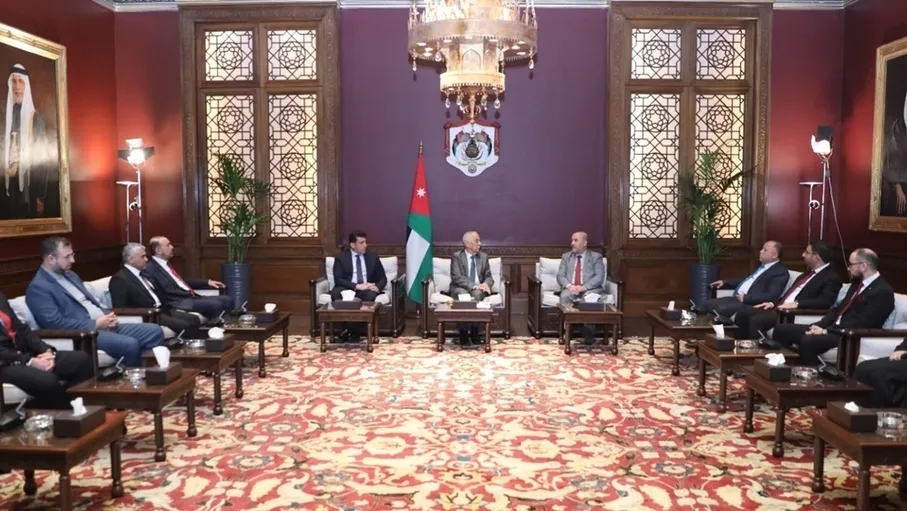منهجية "النشاطات اللامنهجية"..!

في مدرستنا الابتدائية في السبعينيات، كانت حصص الرياضة والفن تُشغل بشكل جيد نسبياً -وإنما لم تكن لدينا حصص للموسيقى. في حصة الرياضة، كان المعلمان المسؤولان عن هذه المادة حكمان معتمدان لمباريات كرة السلة والطائرة، ولهما صلة وثيقة بالمجال. لذلك، كنا نحضر معنا أيام حصص الرياضة معداتنا البسيطة ("شورت"، و"تي شيرت"، وحذاءً رياضياً بسيطاً)، ونخرج إلى ساحات المدرسة. وكان لدينا ملعب لكرة السلة، يمكن أن يتحول إلى ملعب لكرة الطائرة؛ وحفرة مستطيلة مملوءة بالرمل لممارسة القفز الطويل والقفزة الثلاثية، وساحة علوية أكبر من ملعب كرة اليد. وكان المعلم يقسمنا بعد تمارين الإحماء إلى فرق لمختلف الألعاب حسب الرغبة، ويوزع علينا الكرات والأدوات. وكان لدينا، فيما أذكر، رماح وكرات حديدية ومعدات أخرى. وكانت لدينا فرق تنافس جيداً في الدورات الرياضية المدرسية وألعاب القوى. وقد دخلتُ ستاد عمان الدولي لأول مرة في المرحلة الإعدادية، حين حضرنا دورة الألعاب المدرسية لنشجع زملاءنا في ألعاب القوى. وكان يوماً لا يُنسى.
وفي حصص الفن، كنا نغادر غرفة الصف ونذهب إلى "غرفة الفن" في الطابق الأرضي، في خروج محبب عن الروتين. وهي قاعة يشرف عليها معلم مختص رائع. وهناك، كانوا يعطوننا "المعجونة" لتكوين الأشكال، أو أقلام الرسم الخشبية والبلاستيكية والباستيل، ودفاتر رسمنا التي يحتفظ بها المعلم. وفي بعض الأحيان، كان المعلم يرسم على اللوح الأسود بيضة ويحولها إلى حصان، ويطلب منا أن نرسمه باتباع نفس الخطوات. وفي "الإعدادية"، حاضر فينا عن نظرية الفن وتاريخه. وبشكل عام، خرَّجت مدرستنا فنانين، وتزينت جدرانها برسومات وخطوط الطلبة المبدعين.
لا أتحدث هنا عن مدرسة خاصة عالية الأقساط، وإنما عن مدرسة لوكالة الغوث في عمان. وكان الشيء الوحيد الذي ينقص تلك المدرسة القوية جداً في التعليم الأكاديمي أيضاً، هو حصص الموسيقى، حيث كانت الآلة الوحيدة المتاحة هي الأدراج الخشبية التي يعزف عليها الموهوبون في ضبط الإيقاع حيثما تيسر. لكن ما أريد قوله هو أن تلك المدرسة لم تكُن تهمل النشاط البدني والفني وتحوِّل حصصهما إلى "لانشاط" على الإطلاق. ولم يكُن معلمو هذه الأنشطة يتحايلون على ما يعملون فيه، وإنما يشتغلون بما هم أهل له بكامل العناية والشغل واكتشاف المواهب وتطويرها. وأتذكر أن أستاذ الفن كان يسمح لي، مع آخرين، باستعمال المرسم والأدوات في غير حصص الفن، لتطوير ما لدينا في ذلك الوقت. وكان أول من علمني أنه ليس هناك عيب في رسم الجسم البشري بأي كيفيات.
لأسباب كثيرة يصعب سردها هنا، ما تزال حصص النشاط الفني والرياضي مهملة في مدارسنا، ولا يكاد يُبذَل جهد يُذكر لاكتشاف مواهب أولادنا وتطويرها. وقد عنت تسمية "النشاطات اللامنهجية" التي تطلق على هذه المجالات، أنها غير ضرورية مطلقاً وفائضة تماماً عن الحاجة. وإذا كان أولياء الأمور منشغلين عن اكتشاف تميز أولادهم في شيء، أو حالت أحوالهم دون تزويدهم بالأدوات والدورات، فإن آلاف المواهب من أبنائنا تذهب -كما يمكن أن أزعم باطمئنان- من دون أن يلحظها أحد. وهذه خسارة كبيرة.
المفارقة البائنة هنا هي أن هذه "النشاطات اللامنهجية"، تصبح مهمة فجأة حين يقدر لواحد من أبنائنا أو بناتنا التميز على مستوى عربي أو دولي. وقد شاهدنا في السنوات الأخيرة ظاهرات تجسد هذه المفارقة، سواء بفوز أبنائنا في المسابقات الفنية أو الرياضية. فإذا كنا نفرح بمنجزهم ونتحمس ونمتلئ بمشاعر الفخر الوطني على المستوى الشعبي، فلماذا لا تصبح هذه الحالات الوطنية أكثر تكراراً، بدءاً من الاعتراف بأهمية هذه النطاقات والتركيز عليها؟
أتصور أن الذي ينشأ مع تعاطي الموسيقى في المدرسة، أو يتميز في رياضة أو فن، سيكون أقرب إلى النعومة الإنسانية وأبعد عن التطرف والشوفينية. لذلك يُعدِم المتطرفون آلات الموسيقى باعتبارها نقيضهم. وسوف يكون الشاب الذي يقضي وقتاً في عزف آلته أو التدرب على رياضته أو الاشتغال بنشاط فني، أفضل من واحد لا يعرف كيف يشغل وقته، فيشتغل بغيره.
لذلك، يبدو الازدراء السائد لهذه "النشاطات اللامنهجية" منهجية رديئة الوجهات في حد ذاته (بقصد أو بغير ذلك)، والتي ينبغي تغييرها في إطار خططنا الوطنية لتطوير التعليم والثقافة، ومكافحة التطرف.