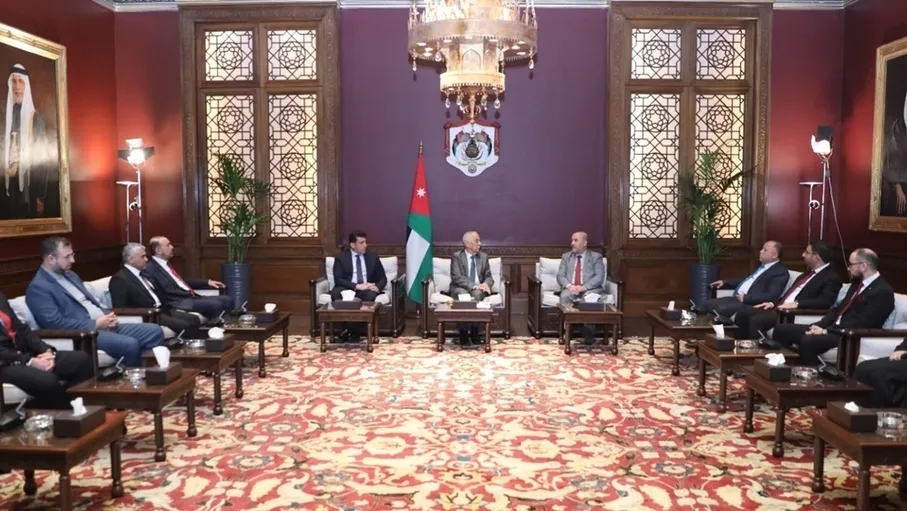أهمية المذكرات

الأطباء الحفاة والمعلمون الجوالون
كانت المخافر والثكنات العسكرية هي أول التعليم في الأردن، فقد تم اعتمادها واعتماد نمط جديد من المعلمين المتنقلين «الجوالين» في بداية الثلاثينيات، لتعليم الجنود وتدريسهم وإزالة أميتهم، وسط إقبال كثيف على «فك الحرف» الذي كان لغزًا.
وقد سبق بلدُنا بأسلوب المعلمين المتنقلين، الثائر الأسطوري ماوتسي تونغ، زعيم الثورة الصينية العظمى ضد الاستعمار الياباني، الذي استحدث عام 1949 أسلوب «الأطباء الحفاة»، وهم الأطباء الذين انتشروا يخوضون، حمأة مزارع الأرز، في بر الصين الشاسع الكبير، لمعالجة القرويين مجانا في قراهم.
تولت القوات المسلحة الأردنية- الجيش، عبر مدارس الثقافة العسكرية تبعات التعليم وأعباءه في البادية الاردنية التي لم تتمكن وزارة التربية والتعليم «وزارة المعارف آنذاك» من الوصول إليها. وايضا بهدف تعليم أبناء العسكر الذين سيصبحون عسكرا يرثون الشعار والبوريه والبندقية والعزم والخشونة من آبائهم. فتم إنشاء مدرسة القويرة وكلية الشهيد فيصل عام 1946 ومدرسة النصر- مدرسة الثورة العربية الكبرى عام 1949 والمدرسة الهاشمية في المفرق.
عثمان بدران خاض معركته وهو صائم
درّسَنا في المدرسة العسكرية الهاشمية في المفرق، معلمون عسكريون من مختلف الرتب العسكرية، برئاسة ضابط دمث طيب هو الملازم عادل محمد حسن. ولن أنسى عندما زار مدرستنا عام 1962 عثمان بدران مدير الثقافة العسكرية، المجاهد الكبير في فلسطين، صديق الشهيد وصفي التل في جيش الإنقاذ الذي حمل لنا حلوى «الككس» التي رايتها للمرة الأولى والتهمت حبة منها بعد أن تأمّلتها طويلا.
وعثمان بدران هو أحد الأساتذة الوطنيين، انتقل بعد نكبة سنة 1948 ليعمل في الجيش العربي الأردني. يقول عنه دولة مضر بدران اطال الله عمره للصحافي الالمعي محمد الرواشدة في الحلقة الثالثة من «سياسي يتذكر» التي نشرتها صحيفة الغد بتاريخ 27 كانون الثاني 2015
(... كما كان ابن عم والدي عثمان بدران قادما من نابلس، ومعه فريق من المتطوعين، خاضوا حربا شرسة ضد العدو على أرض الـ1948 وقد وثق عبدالله التل رحمه الله القائد العسكري للقدس في مذكراته كيف أن «عثمان بدران خاض معركته وهو صائم).
كانت المدارس العسكرية تتميز بالجدية والصرامة والضبط والربط. وكان الطلاب كأنهم جنود في ثكنة عسكرية، وقد صقلت شخصيتي كثيرا السنوات الأربع التي درستها في تلك المدرسة، السادس والسابع والثامن والتاسع ( 1959-1963). في عام 1963 قدمت امتحان الثالث الإعدادي العام على مستوى المملكة، وأظن أنني أحرزت اعلى العلامات فيه.
حصلت على ميدالية
ذهبية بكرة القدم عام 1962
أحرز فريق مدرستنا بطولة مدارس القوات المسلحة بكرة القدم عام 1962 في المباراة النهائية بيننا وبين مدرسة الفتح، بهدف سجّله من كرة مرتدة من ركلة جزاء، الصديق الحميم -إلى اليوم- على سلامة محمد أبو فلاحة المشاقبة، وحصلنا على الكأس وشبعنا من حلوى «الككس» الذي ابتاعه لنا معلم اللغة الإنجليزية والرياضة الأستاذ جميل الخزوز، من جيبه الخاص. كنت ألعب في الفريق الذي اذكر منه، يعقوب أبو الهول وعلى خلف الحمود وفرح الربضي، ظهيرا أيسر (هاف باك) فحصلت على الميدالية الذهبية التي تباهيت بها أمام صديقتي عدة أيام، وقد عرضتها عليها فخشيَت أن تأخذها فيراها أهلها، وأمام إلحاحي تجاسرت ووافقت على أن تأخذها فتضعها تحت وسادتها لليلة كاملة ثم تعيدها لي مضمخة برائحتها. اكتشفت عندما حاولت بيع الميدالية الذهبية -بسبب الطفر- أن ليس فيها من الذهب غرام ذهب واحد وإنها مصنوعة من البرونز الذي لا يساوي شيئا.
كان المعلمون أول الطلائع الأردنية المباركة التي رادت القرى، قبل الصحة والطرق والهاتف بسنوات، وقد أسلفت ذكر المشاق والقسوة والصعوبات التي عمل فيها المعلمون دون تبرم أو تذمر، ولما سردت لجدي ما الذي كنا نعمله من غسل وبح وكوي وكنس وطبخ وجلي وعجن وخبز وتحطيب ونتف ريش الشنانير التي نصطادها وذبح الخراف التي نشتريها وسلخها وتقطيعها قال مستغربا: كل شي عملتوه وما ظل غير ترضعوا !! في إشارة منه الى اننا عملنا الاعمال النسائية كلها الا الإرضاع.
غبت عن المدرسة أسبوعين دون علم أهلي، كنت اخرج صباحا والتقي بصديقين فارين مثلي فننطلق إلى تسلق الأشجار ولعب كرة القدم وتقليد الهنود الحمر في زعيقهم ورمي السكاكين وصنع الرماح.
سمعت أمي قرعًا على الباب وكان الوقت عصرًا ولما فتحته سمعتُ صوت رجل يتحدث معها، ميّزت صوته، هذا مدير مدرستي عادل محمد حسن، عندما علم أنني في المنزل رفع صوته ونادى عليّ طالبا أن يراني، كانت أمي مصعوقة بسبب غيابي السري عن المدرسة، دخلت ودموعها على عرض وجهها. قال لي المدير: ارجع إلى مدرستك من الصبح. قلت: ولكنني سأتعرض للعقاب. قال: هالمرّة سماح يا محمد، ما في معلم رح يحكي معك، ارجع على كفالتي.
كانت على المعلم مسؤوليات تتعدى غرفة الصف وتتجاوز سور المدرسة، مسؤوليات تتنوع وتتوزع على مختلف شؤون الحياة الخاصة بطلابهم.
دعوات الأمهات المستجابة
كنت في الصف الثالث الإعدادي، قررت أن اترك المدرسة وان أسجل في الجيش، اتفقت مع فايق غديفان على الذهاب معا، استيقظت مبكرا على قرع فايق على الباب وعندما فتحت الباب لأغادر المنزل فاجأتني أمي بسؤال: إلى أين في هذه الساعة المبكرة؟ ذكرت لها أي سبب وخرجت.
كان الناس يدخلون كالنهر إلى معسكر «خو» قرب الزرقاء، أباء وأمهات واعمام واخوال واخوة كبار يصطحبون أبناءهم للتسجيل في الجيش، يعبرون بوابة عرضها يزيد على عرض ملعب كرة القدم وعلى طرفها يجلس غفير يضع بندقيته على فخذيه.
عبرنا البوابة فإذا بالغفير يصرخ: انتا انتا، ارجع. رجف قلبي، تجاهلته ولم التفت فلعله يقصد شخصا غيري. انتا يا ولد أقلك ارجع. كان صوته غاضبا وكانت يده على كتفي. ما تسمع؟ أقلك ارجع. عبر فايق ورجعت.
كنت الوحيد الذي رجع من بين مئات الشباب العابرين تلك البوابة العريضة. ناورت، مشيت مسافة طويلة وعملت حركة التفاف على زاوية شيك المعسكر الذي رفعته وانحنيت فدخلت إلى المعسكر وتوجهت إلى قاعات استقبال المجندين الجدد. سمعت الغفير يصرخ: ارجع ارجع. توقفت. رايته يصوّب بندقيته من بعيد نحوي وصرخ: اطخك إن ما رجعت. رجعت، غادرت خو مكسورا ودموعي على عرض وجهي.
عندما فتحت لي أمي باب المنزل عصرا قالت لي: أنا لا اعرف إلى أين ذهبت يا محمد وماذا كنت تنوي أن تفعل لكنني رفعت كلتا يدي إلى السماء ودعوت عليك قائلة: الله لا يوفقك يا محمد في مشوارك اليوم !!
قلت لنفسي إن الغفير، الذي دقر لي وترصّدني واختارني من بين مئات الشباب، العابرين بوابة ليس لها غفير في العادة، وأرجعني وحدي، دون أي مبرر أو سبب، ينفذ دعاء أمي الذي غيّر مسار حياتي ومصيري !!
وبعد نحو ستة أعوام التقيت بمديري الغالي عادل محمد حسن في وزارة التربية والتعليم أخذته بالحضن وعبرت له عن شدة احترامي له، كان على عجلة من أمره في طريقه إلى اجتماع، لكنه سألني سؤالا هزّني ولا يزال إلى اليوم يهزني ويثير استغرابي وحيرتي: انتا ما سجلت بالجيش يا محمد؟ قلت له: رجّعوني، ما سمحوا لي. ابتسم ابتسامة غامضة ومضى.
ما الذي حصل آنذاك؟ من الذي لعب ذلك الدور الحاسم في حياتي؟ أهو دعاء أمي بان لا يوفقني الله في مشواري، أم هو مديري عادل الذي المح الماحة هائلة تدل على معرفته بما عزمت عليه وما حصل معي. هل هو من كان في سيارة الجيب العسكرية التي مرت بقربنا والتي لمحت فيها، من خلال غبارها الكثيف، ضابطا يشبهه وأنا في الطريق إلى معسكر «خو».
عاد فايق بعد شهرين وهو يرتدي «البذلة» العسكرية والطماقات والقايش والبسطار والبُريه التي يزينها شعار لامع. كانت محفظته عامرة بالليرات، جعلني زيُّ فايق ومحفظته في ذروة استيائي وسخطي على أمي. وكانت المرارة تملأ حلقي والغيظ والغضب يسيطران عليّ لشهور.
خلف الناطور، عبدالله تليلان، ذوقان عبيدات
لعب المعلمون أدوارا كبيرة في حياتي وجمعتني بهم صلات طيبة وسأظل اذكر العصامي الجاد معلم اللغة الإنجليزية خلف الناطور المخزومي وعبد الله تليلان معلم الرياضة المحترف المخلص وعادل الشريقي وأبو علاء الداغستاني والدكتور ذوقان عبيدات الذي درّسنا في معهد التأهيل التربوي في المفرق وتبادلت معه الكتب في حينه، وعشرات المعلمين الذين ستستردهم الذاكرة ولو بعد نصف قرن.
عندما أصبحت صحافيا بحثت عن عثمان بدران وأجريت معه لقاء صحافيا حدثني فيه عن ذكرياته وتاريخه الجميل النبيل، نشرت ذلك اللقاء على صفحة كاملة في صحيفة «صوت الشعب» تحت عنوان «وجها لوجه». وعندما أصبحت وزيرا للشباب بحثت عن أستاذ الرياضة عبد الله تليلان وتمنيت عليه أن يقبل عضوية اللجنة الأولمبية الأردنية فقبل. وبحثت أيضا عن المبدع المتميز الدكتور ذوقان عبيدات وتمنيت عليه أن يقبل موقع أمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية فقبل.
اشعر أن ذكرياتي هذه كمعلم أوشكت على التمام وأنها أدت الغرض منها. ولطالما خشيت أن أكون أطلت إلا إن الأصدقاء الذين تابعوا هذه الكتابة ظلوا يلحون عليّ بان أواصل، علما إنني اكتبها في سهرات تمتد ساعات. ويجدر أن اذكر أنني اكتبها بمنتهى الاعتناء والتدقيق.
ثلاثة: ناهض حتر وجمال ناجي وعمر داودية
ثلاثة أصدقاء كان لهم ادوار كبيرة في دفعي الى كتابة هذه الاحداث والوقائع «السردية»:
صديقي الشهيد ناهض حتر الذي قال لي انه مبهور بجمال هذه الكتابة. ودعاني، في حديث طويل كشف عن ما اذهلني من ثرائه الروائي والادبي، الى كتابتها وطباعتها في رواية تصف اكثر واكثر تفاصيل المكان. وتظهّره وتعطيه عمقه وابعاده وحقه. وتظهّر كذلك الشخصيات وتصفها وتضفي عليها ظلالها ورتوشها وملامحها التفصيلية الدقيقة. كان ناهض ذا قراءة تكميلية للنصوص، التي كان يستمع الى تفاصيل كثيرة منها، خلال لقاءاتنا الطويلة التي امتدت من أواخر السبعينيات الى أواخر الثمانينيات ولم يكف عن حثّي على كتابتها.
والثاني هو صديقي العتيق العريق جمال ناجي الروائي المحترف البارز الذي سجّل على كتابتي ملاحظات مفيدة عديدة. علما انني لا اطمح الى كتابة رواية بالمعنى الكلاسيكي ولا اسعى الى كتابة «سيرة» بالمعنى السردي الجاف، فما كان من جمال الا ان اقترح إطارا هو «سيرة روائية».
اما الصديق الثالث فهو ابني عمر داودية. لقد حثّني عمر طويلا على كتابة هذا اللون. كنت أقص عليه دائما وعلى أسرتي أحيانا، بعض ما جرى معي ولي. وبعد أن بدأت، واصل إبداء ردود فعل مشجّعة اعتمدتها، لأنني اعتبره ضميري وناقدي الذي أثق بسلامة ذائقته، ودعوني افصح عن حالة هي ان عمرا يمكن ان يكون كاتبا ويمكن ان يكون روائيا، اما ما هو عليه الان فهو من ابرز قراء الروايات العرب. وهو مرجع يُستنصح لمن يتطلع الى قراءة روايات جميلة بالعربية او بالانجليزية.
اذن. لم افكر حتى في التقدم لكتابة رواية «تسجيلية» او حتى لكتابة «سيرة روائية» لانني تصعقني القحة والتطاول على كتابة الروايات والدواوين الشعرية التي ملأت المكتبات غثاء وركاكة. وأيضا لأنني اتابع بشغف واهتمام ما يكتب من روايات اردنية -وطبعا عربية وعالمية- فأنا مدمن قراءة روايات وارى ان قراءها لا يزيدون على العشرات. وارى ان القراء عندنا يحرصون على شراء الروايات التي تفوز او تُفوّز بالجوائز والمسابقات واعرف ان عدد هؤلاء لا يزيد على 100 كما علمت من احد الأصدقاء المختصين بالتوزيع.
كان للتعليقات الكثيرة على الفيسبوك دور حاسم في الاستمرار ومواصلة الكتابة وقد استغربت كيف يهتم أبناء هذا الجيل بتلك المعاناة التي مر عليها نصف قرن وأصبحت من الماضي. واسمحوا لي أن أوجه التحية الحارة لمن واكبوا هذه الذكريات وساهموا في استمرارها بالتوجيه والنصح والاستزادة:
هؤلاء وغيرهم تذوقوا وحثّوا
الدكتور ممدوح العبادي، هشام التل، المهندس مالك حداد، العين يوسف القسوس، جميل النمري، العين مازن الساكت، سالم الخزاعلة، محمد التل رئيس تحرير الدستور، الصحافي اسامة الرنتيسي، د.عرفات الاشهب، المهندس عبدالباسط أبو الذنين، المهندس عزام الهنيدي، عبدالكريم أبو الهيجاء، حسن الجزازي، علي الصمادي، خالد الدعجة، بشير الرواشدة، المهندس مبارك الطهراوي، المحامي د. إبراهيم الطهراوي، د. بسام البطوش، نايف الشواقفة، نوفان الشواقفة، الدكتور حسين العموش، صدقي الفقهاء، د. رضوان محادين، عبد المهدي علي التميمي، حنان مهيار، وسام الخليلي، المهندس سهيل حداد، د.سليمان الفرجات، البروفيسور عصام سليمان الموسى، نصر سالم الحباشنة، الصحافي حامد العبادي، المهندس مالك نصراوين، د.سميح عريقات، خالد الحسينات، خميس أبو زيد، الصحافي نايف الطورة، جمال حمد الحجاج، المهندس د. قبلان السكارنة العبادي، موسى الطراونة، رجا الخوالدة، زهرية الصعوب، د.منار النمري، سعد العشوش، مروان المعايطة، الفنان محمد الجالوس، رائد الناصر-استراليا، المحامية نرمين المعايطة، عبدالله الخوالدة، المهندس سمير سليمان، الكاتب حكمت النوايسة، فارس عيد غنام، الشاعر سرحان النمري، عبد الله ارتيمة، د.غازي الكوبري، عوني فاخوري، نبيل داودية، د.عمار المعايطة، المهندس حازم عبيدات، الشاعر سليم الموسى، ناصر الخزاعلة، د.بشار الخرشة، عيسى العمري، اياد العمري، د. نضال الملكاوي، فراج فراج، عيسى بطارسة، عبدالسلام الطراونة، منال النظامي، محمود كساب، رانيا محمود كساب، سامي دهيمات، فادي الشبيل، مجدي وشاح، مي بصبوص، عبد الوهاب الرواجفة، نانسي الرفاعي، رامي علاونة، منذر دبابنة، جودت رفايعة، محمد موسى المرقطن، مبارك العمري، منى القسوس، محمد عبد العزيز الخصبة، عبد القادر التميمي، رومي الملكاوي، عبدالرحمن محمد الداودية، باسل شناق، رجب الربيحات، راجي دبابنة، غسان كساب، عمرعدنان المراحلة، احمد النشاش، محمد بني خلف، حسن أبو شاور، عبدالله احمد علاوي، جودة شنك، اكمل حداد، مجلي بوالصة، احمد الخوالدة أبو باسل، عدنان حدادين، علي الرعود، نضال نايف شواقفة، المحامي ناصر غرايبة، عقبة أبو هدهود، محمد سلطي جداية، د.سفيان الحجايا، د.محمد محافظة، عطالله علي حسون، سنان عمريين، غالب سلمان، ، فراس القعقاع، وليد بقاعين، خالد الحسبان، مازن الجريري، ظافر أبو البندورة، فارس دبابنة، طارق بني ياسين، بلال برهم، ماجدة عبويني، رائد البداينة، عطالله البداينة، عواد فنخور، عبدالكريم عقاب الخالدي، نوفان كراسنة، الدكتور المهندس كمال أيوب، تيري جنتين، مهند تادرس، مأمون عياش، عبد السلام العودات وغسان طاشمان.
وفي اخر الكلام فإن الناس تحب المذكرات والذكريات. وأنا من هؤلاء. من الذين ادمنوا -ولا يزالون- قراءة المذكرات. وتزداد أهمية المذكرات واقبالي عليها، عندما تحمل ملامح بلادنا ولون عيوننا ورائحة ترابنا وهمومنا وقضايانا. عندما تكون محلية اكثر.
لقد نصحني عدد من الأصدقاء بان اطبع هذه «السردية» الذكريات طباعة شعبية، على ورق غير مكلف «ورق صحف» بهدف تجميعها وتوزيعها كهدية مجانية من صحيفة الدستور الى قرائها. وها أنا ذا افكر في ذلك واقلب الفكرة.