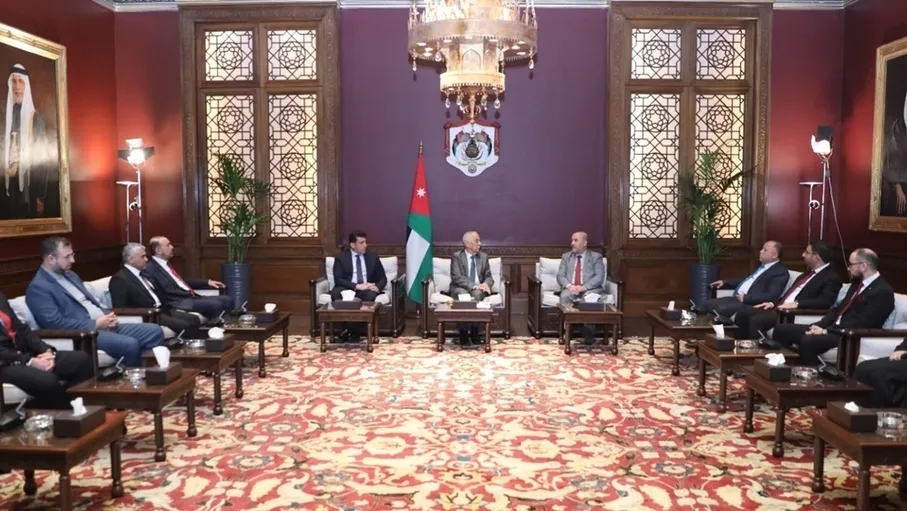الإصلاح يليق بالأردنيين

صحيح أن "الربيع العربي" انتهى، وتحوّل إلى حالة مشوهة لا يخرج منها إلا الدم والقتل والعنف، في سورية وليبيا واليمن وغيرها. وصحيح، أيضا، أن أنظمة الاستبداد التي أسقطتها الشعوب الغاضبة، قد نجحت في إعادة إنتاج نفسها بأكثر من صورة.
وبالنتيجة، فقد شاع "ما بعد الربيع" شعور بالراحة والاسترخاء لدى جبهات ممانعة التغيير، بحيث تراها تعود صراحة الآن إلى اتخاذ موقف معاد لكل الشعارات التي رفعها الشباب العربي.
"حرية.. كرامة.. عدالة اجتماعية" هو ما حلم به هذا الشباب، قبل أن تتحول أحلامهم إلى كوابيس جرّت لهم مزيدا من التهميش والقهر، والأهم هو الشعور بضعف الحيلة والعجز عن التأثير.
لكن الشعارات التي رفعها الثائرون لن تفقد بريقها، لاسيما أن فيها مصلحة للأنظمة قبل الشباب. فهذه الوصفة، والسعي إلى تحقيقها، هي ما سيجلب الخير والازدهار لا للمجتمعات فحسب، بل للدول التي تخطط لرسم مستقبل آمن مستقر.
التفكير مليا بالشعارات ضرورة، بحيث يقوم على احتساب المنافع والأضرار. وهذا يحتاج إلى عقل بارد، وصوت حكيم يؤكد أنه بهذه الشعارات، إن تحولت إلى سياسات، تتجسد وصفة الخلاص، بتجنب غضب الشباب المتواري اليوم، إما خوفا أو حرصا.
في الأردن، يصح تماماً القول إن الحال عندنا مختلفة. فالبلد تجاوز الأصعب، والمجتمع رغم علله وأوجاعه، حريص على استقرار حاضره. لكنه أيضا قلق على مستقبله؛ كمن يجلس على صفيح ساخن.
وهذه الحقيقة تستلزم مقاربة مختلفة، تبتعد عن الحلول الأمنية، بل قد تتطلب ربما رؤية مختلفة تتقدم على المجتمع نفسه، وتقوم على أخذ الوطن إلى طريق ثالث لا يشبه ما نحن فيه اليوم، مع تذكر أننا أفضل من غيرنا، وقد تجاوزنا الأصعب باقتدار، فكيف الحال مع قفزات محسوبة ومدروسة بعناية.
إذ بعد كل ما مر به الأردن بنجاح وثبات، كيف لأحد أن يعتقد أن الديمقراطية الحقيقية بدعة لا تليق بمجتمعنا؟! وكيف له أن يظن أن المضي في الإصلاح، للبناء على تطور الملكية نظام حكم، هو أمر غير مفيد؟!
السنوات الماضية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الأردنيين جديرون بالتغيير، وأن لديهم وعياً ساعد مؤسسات الدولة على تجاوز الأصعب. كذلك، تؤكد تجربة الفترة الماضية، أن كل الشعارات السابقة تليق بالأردنيين؛ فهم من رفضوا الفوضى وتمسكوا بالعقيدة التي نشأ عليها هذا البلد، فما الضرر في العيش الكريم والعدالة والحرية والديمقراطية، طالما أن الأساس واضح لا خلاف عليه؟
الأجيال الشابة الحالية لديها تجربة وتنشئة مختلفتان عنهما قبل التطور التكنولوجي. فالجيل الجالس اليوم على مقاعد الدراسة، ينظر حوله ويتعلم كل صغيرة وكبيرة تقع في هذا العالم، وعالمه أوسع بكثير مما نعتقد. ومن ثم، فإن الاستعداد لتطلعات هذا الجيل والأجيال التالية يغدو أمرا لا مفر منه، حتى لا نعاني من فجوة كبيرة بين ما هو موجود وما يريدونه ويحتاجونه.
التخطيط لمستقبل أفضل للجميع، ربما يحتاج إلى قلب المعادلة؛ بحيث يرفع المسؤولون شعارات العيش الكريم والعدالة والحرية والديمقراطية، ويسعون إلى تحقيقها، حفاظا على المصلحة العامة التي يزعمون الحرص عليها. إذ إن رسم الأفق وبناء الأمل بالمستقبل لدى الأجيال الشابة، يحتاج منا جميعا التفكير بشكل وأسلوب مختلفين.
بصراحة، يصعب علي أي أب أن يفرض على أبنائه التفكير بطريقته، لأن زمانهم غير زماننا.