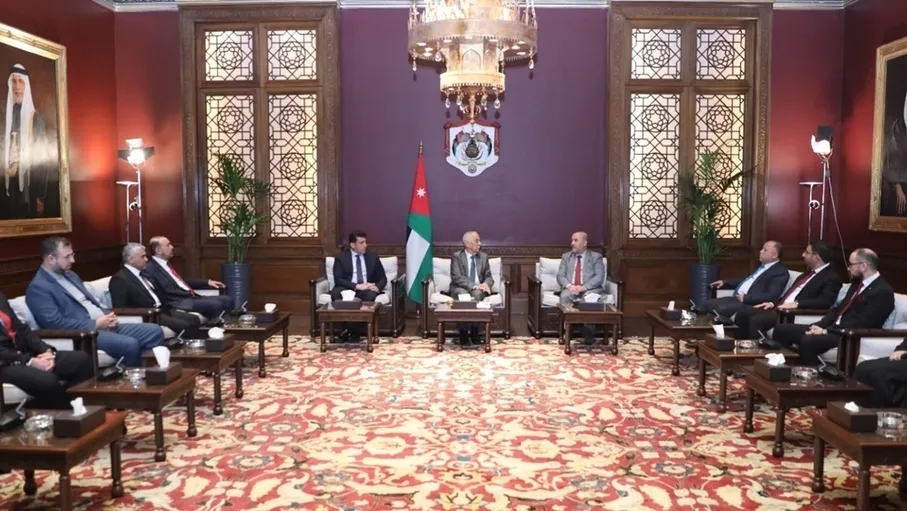أزمان مختلفة

ما الذي كنّا سنبدو عليه لو أننا نشأنا في الزمن الحاضر، خلال سنوات انفجار “البدع” الجديدة من صنوف التواصل والترفيه.
في سنوات طفولتنا ومراهقتنا، كان الطرب يأتينا عبر الراديو من محطات معدودة، فاعتادت آذاننا على أم كلثوم وفريد وعبد الحليم وفايزة ونجاة ووردة وعبد الوهاب، وغيرهم.
الدراما، تعرفنا عليها من التلفزيون الأردني الذي كان يبدأ بثه في الرابعة عصرا، ويختم قبل منتصف الليل. دراما بقصص قريبة منا ومن مشاكلنا والصعوبات التي تواجهنا.
لم تكن هناك محطات فضائية بعدد سكان الكرة الأرضية تحيّرنا ونحن نمسك الريموت كونترول ونقلب بينها لنصطفي واحدة توافق مزاجنا.
التلفون الوحيد الذي عرفناه، كان في الدكان الوحيدة للقرية، وكان لزاما عليك أن تطلب مقسمين على الأقل قبل أن يحولك إلى الرقم الذي تريده.
عزيزنا مارك زكربيرغ، لم يكن قد ولد، ولم يكن قد تحوّل الناس جميعهم إلى كتاب ومفكرين وفلاسفة ومخترعين وشعراء على صفحات وهم اسمه “فيسبوك”!
“نعمة” الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية غابت عن تلك الفترة، فانصرف جيل بأكمله إلى أمور أقل توهجا وأهمية!
في تلك السنوات، اكتشفنا إغواء الكتاب، فغرقنا فيه من غير أي ندم. بدأنا بالأدب والشعر العربي الكلاسيكي، منذ الفترة التي وصفت، ظلما، بالجاهلية، وتدرجنا حتى وصلنا إلى نجيب محفوظ وإدوار الخراط وغالب هلسا وتيسير سبول، ثم تحولنا إلى الأدب الاشتراكي الطاغي وقتها، فجلنا معه في ربوع الاتحاد السوفياتي وأميركا اللاتينية ودول الكتلة الاشتراكية. لم يكن هناك من دليل معين لما نقرؤه، فوضع كل واحد منا دليله الخاص.
في تلك الأعوام، كانت مجالات الترفيه في حدها الأدنى، لذلك اجترحنا ترفيها مناسبا يلملم تشظينا القليل في عالم لم يكن واسعا كما هو الحال عليه اليوم.
لم يكن السيد غوغل قد أهدانا بركاته بعد، والمعلومات التي كان يستند إليه الرفاق في نقاشاتهم الطويلة، كانت حصيلة أيام من القراءة والتمحيص، وليس كما هو اليوم، مجرد بحث عن كلمة مفتاحية، لتظهر المعلومة، ولا يبذل “المثقف” أي جهد سوى بتظليلها ونسخها، ومن ثم لصقها في المكان المناسب.
ترى، ما الذي سيكون عليه الحال لو تأخر جيلنا إلى هذه الأيام، حيث تتشعب الحياة في اتجاهات شتى، ولا بوصلة لتدل على جهة معلومة!
لا ألوم جيل اليوم على أي شيء!