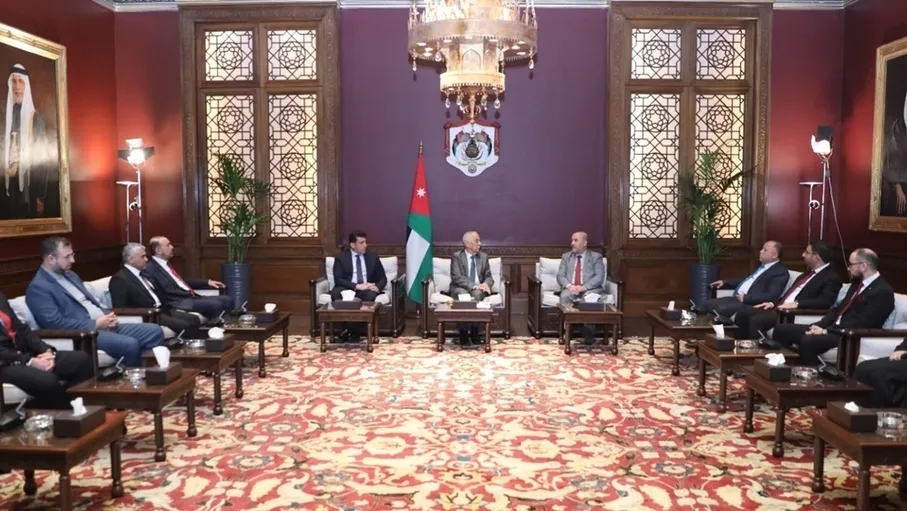حلب والحروب الجديدة

حلب، وما يجري فيها من قصف راهن، هو امتداد لحروب ومعارك يعيشها العالم منذ نهايات الحرب الباردة، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في تسعينيات القرن الماضي. وتقوم هذه الحروب على أساس الهوية، وتعتمد على نشر الخوف والكراهية، أكثر مما تعتمد على كسب التأييد؛ ولا ترى في كل من يحمل هوية مخالفة، أو حتى موقفا مختلفا، إنساناً يستحق الوجود.
ما يحدث في سورية لا يختلف كثيراً عما حدث في يوغسلافيا السابقة، في التسعينيات، عندما قسمت يوغسلافيا على أساس ديني وعرقي.
تحدثت ماري كلدور، في كتابها الصادر العام 1999 بعنوان "الحروب القديمة والجديدة.. العنف المنظم في عصر عولمي"، عن أنّه في حرب العصابات الكلاسيكية، كما طورها القائد الصيني الثائر ماو تسي تونغ، والكوبي الأرجنتيني تشي غيفارا، كان السعي للحصول على "عقول وقلوب الناس هو الأساس"، ولأهداف جيوسياسية، أو أيديولوجية. أمّا في الحروب الجديدة، فإن المطلوب هو زرع بذور "الخوف والكراهية". والمطلوب هو "السيطرة على السكان بالتخلص من كل من لديه هوية مختلفة، وكذلك كل من له رأي آخر".
بحسب إعلامي تابع للمعارضة السورية، فإنّ الهدف من وراء "الجرائم" الأخيرة التي يرتكبها النظام هو "إخلاء مدينة حلب من السكان الأصليين، وتغيير الطبيعة السكانية للمدينة"؛ فليس المطلوب كسب عقول أو قلوب أحد، ولا بأس من التخلص من كل ما هو مخالف. والأمر ذاته تمارسه تنظيمات من قبيل "داعش" وما شابهه من تكفيريين في سورية، بقطع الرؤوس، وممارسة القتل لكل مخالف.
المدافعون عن النظام السوري، باعتباره دفاعا عن سورية علمانية تقدمية، لا يستوقفهم القتل الذي يمارسه النظام، فمن قواعد الحرب الجديدة أنه لا بأس من اختفاء كل من هو ليس معي. ويمارس هؤلاء الأنصار لعبة تريحهم؛ هي اعتبار أي أنباء عن القتل مؤامرة إعلامية. وهم، كما هو الفكر الداعشي ومشتقاته في الحروب الجديدة، يؤمنون أنّ "من ليس معي" لا ضرورة لبقائه على قيد الحياة، بل يفضل أن يختفي، وفي أحسن الأحوال لا نكترث له.
هي صراعات حول من يبقى موجوداً، ولا شيء آخر مهم، وحتى جوهر الوجود غير مهم.
بالنسبة للنظام، فإنّ الاستمرار بالوجود ومن دون أي إصلاحيات سياسية من أي نوع، هو الموقف الوحيد الواضح، وبالتالي يتم تصوير كل من يعارض النظام، بل كل من لا يدافع عن النظام، بأنه عميل وجاسوس وتكفيري وجزء من مؤامرة، ولذا يجب الابتهاج بفنائه. أمّا المعارضة، غير التكفيرية، فتعجز عن طرح خطاب متكامل، سوى زوال النظام، وتستخدم أحياناً خطابا ماضويا، بما في ذلك استخدام رموز عثمانية تركية، كاستخدام تسميات مثل فرقة السلطان مراد، ومحمد الفاتح.
دولياً، لا يريد الروس سوى دعم النظام في حدود قدراتهم العسكرية، وظروفهم السياسية. أمّا الولايات المتحدة الأميركية، فتوغل في لعبة "إدارة الصراع"، من دون أي نظر لعملية الحل المتكامل.
الشارع العربي المنقسم في مواقفه مما يحدث في سورية (بغض النظر عن نسب وحجم التأييد لكل فريق)، هو أيضاً لا يكترث سوى بإدانة الطرف الآخر والرغبة بزواله، ولا أحد يقدم أيديولوجيا للمستقبل، وللتعايش، ولكسب العقول والقلوب، أو تصور للمستقبل الجيوسياسي في المنطقة.
فلا بأس لدى النظام وحلفائه من دعم روسي منسق مع الإسرائيليين، والمعارضة لا تستطيع التوحد، أو تقديم خطاب ديمقراطي وعلماني حقيقي. وعملياً، لم يعد يوجد في سورية تباين له معالم واضحة، سوى بين ثلاثة أجزاء؛ النظام أو بقاياه، الذي يقبل بأي شيء يحافظ على وجوده، حتى دعم روسي يقدم ضمانات للإسرائيليين ليتحركوا كما يشاؤون، ولا يقبل أي شيء إلا إذا كان يحفظ وجوده ومن دون أي تغيير أو إصلاحات. والجزء الثاني، "داعش" و"النصرة" والجماعات التكفيرية الأخرى، والتي لا تبتئس إسرائيل حتى من علاج بعض عناصرهم في مستشفياتها. والفئة الثالثة، المعارضة السورية الوطنية، التي لا تستطيع التوحد وتقديم خطاب تحرري متكامل، وتوضيح للمستقبل، إلا في إطار رفض وجود النظام. وأغلب الدول العربية الداعمة للمعارضة لا تكترث بتكرار السيناريو الليبي، طالما يخلصها من النظام.
والمثقفون العرب منقسمون بين التصفيق للنظام وزيارته ودعمه، أو مهاجمته عبر "فيسبوك"، أو الصمت والحياد، من دون أي خطاب للمستقبل أيضاً.