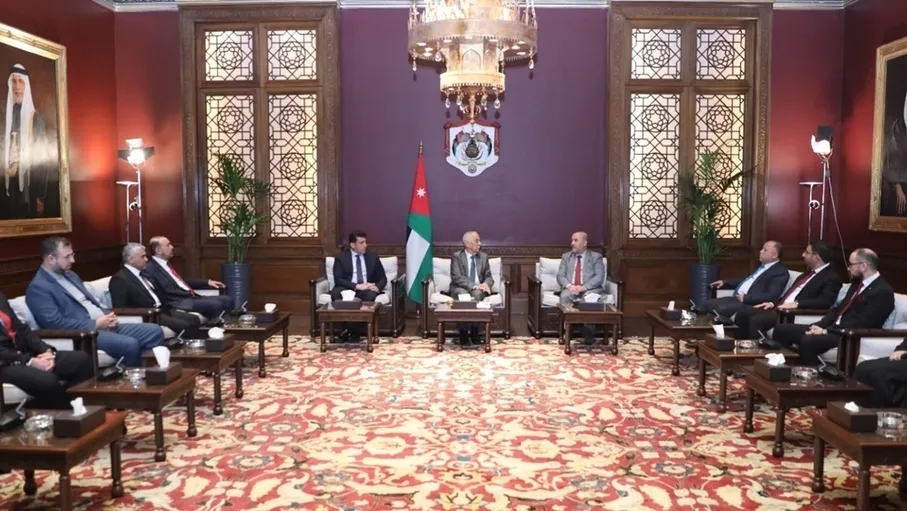حتى لا تكون الانتخابات عبئا إضافيا بلا معنى

نمضي إلى الانتخابات ونحن نفكر بما نريده. فماذا نريد؟ إن البرامج والحملات واللقاءات والنشاطات الانتخابية القائمة، كما المواقف والمعتقدات الأيديولوجية والسياسية والقضايا الكبرى والخارجية، لا تعكس على نحو واضح وصريح ما الذي نريده من الانتخابات. ما نريده بالفعل نعرفه جميعا، لكننا نتواطأ على كتمانه. ولا تمثل الواجهات والإعلانات، وما يقال وما لا يقال، سوى زينة غير ضارة، أو حيلة لتجنب مواجهة أنفسنا بالمحركات والحوافز الحقيقية للترشيح والانتخابات. ففي ظل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية القائمة، لا معنى ولا فائدة أو أهمية في الحقيقة لبرامج انتخابية متقدمة وناضجة، إلا بمقدار تزويد القدر الذي يغلي الحجارة بحاسوب لقياس وتنظيم الاشتعال؛ فينخفض اللهب عند الغليان إلى أدنى درجة، ثم يعاود الارتفاع عندما يبرد الماء، أو أن نضع بجوار القدر حكواتيا وعازف ربابة!
يجب أن يكون هناك أولا نظام سياسي اجتماعي اقتصادي تشكل فيه الانتخابات العامة؛ النيابية والبلدية والنقابية، أداة مرجعية لاختيار قادة الدولة والمجتمعات، والتنافس بين النخب والمجموعات والمصالح. فإذا كانت الانتخابات لا تؤثر جوهريا في تنظيم الدولة والمجتمع، فسوف نهرب بطبيعة الحال من مواجهة أنفسنا بهذه الحقيقة، إلى مقولات وأفكار وقضايا بعيدة وغيبية نداري بها إدراكنا الواعي أو المبهم ولكننا لا نريد أن نعترف به. وقد نبالغ في ضخامة القضايا التي ندعو إليها ونطالب بها، إلا أننا نؤكد عبر ضخامتها وبعدها عن المعنى العملي والواقعي هروبنا وهامشية الانتخابات. فعندما نعرف، بداهة، أن القضايا التي ندعو إليها بعيدة عن مجال الدولة والحكومات، ندرك أيضا أنها مقولات ومطالب وهمية!
هكذا تتحول الانتخابات إلى عمليات اجتماعية واقتصادية ثانوية، لا تؤثر في حراك وتدوير الطبقات والنخب السائدة. لكن يحدث دائما أن العمليات الهامشية تنشئ مع الزمن والتراكم مصالح راسخة وقوية لأفراد ونخب وطبقات وجماعات، تبحث عن مجال في الهامش المتبقي والمتاح؛ مثل بيع شعر البنات والترمس والعكوب بجوار المباريات الرياضية أو على طريق عمان-إربد.
هل يمكن ردّ الانتخابات إلى مجالها الحقيقي المنتج؟ بالتأكيد نعم؛ ربما بنسبة معقولة قد لا تكون هذا العام حاسمة، لكنها يمكن أن تؤسس لتقاليد انتخابية جديدة، أو تساهم في إعادة العلاقة بين المكونات الرئيسة للدولة (السلطة والمجتمعات والمدن والأسواق) إلى سياقها المنشئ، وكما يحدث في التاريخ والجغرافيا وفي الأمم الغنية والفقيرة!
نتجمع ببساطة حول الحريات والعدل. وبذلك، ننشئ مدننا ومجتمعاتنا. ثم نلتفت إلى احتياجاتنا وقضايانا التي فيها معاشنا. فحين يكون التعليم بخير؛ بحيث لا نضطر لإرسال أبنائنا إلى المدارس الخاصة أو ننفق ما يفوق طاقتنا على تعليمهم في الجامعة، ويكون التأمين الصحي كفؤا وعادلا وشاملا، والسكن والنقل متاحين بأجور وتكاليف عادلة، نكون بخير، ونستطيع بمواردنا المتاحة أن نحيا حياة كريمة. لكننا ننفق كل ما نجنيه لأجل توفير متطلبات واحتياجات يجب أن توفر بالضرائب التي ندفعها.
ندفع الضرائب مرتين؛ مرة بما هي ضريبة، ومرة بسبب عدم إنفاقها في الأوجه المفترضة للإنفاق، وبعدالة وكفاءة. وهذه قصتنا. وبدلا من ذلك، فإن الطبقات التي تدفع كل ما تجنيه من عملها ومدخراتها ودخولها الإضافية لأجل تعليم أبنائها، ولأجل علاج وأدوية لا يغطيها التأمين الصحي البائس الذي يساوي عدمه، وإيجار منزل أو قسط ثمنه الذي يبلغ أضعاف قيمته الحقيقية... هذه الطبقات مشغولة بالذين يسبحون في فرنسا، أو بالنزاع بين رجب طيب أردوغان وعبدالله غولن، أو بعيد ميلاد بوتين، أو بقضايا فردية لا تعني الدولة والمجتمعات.