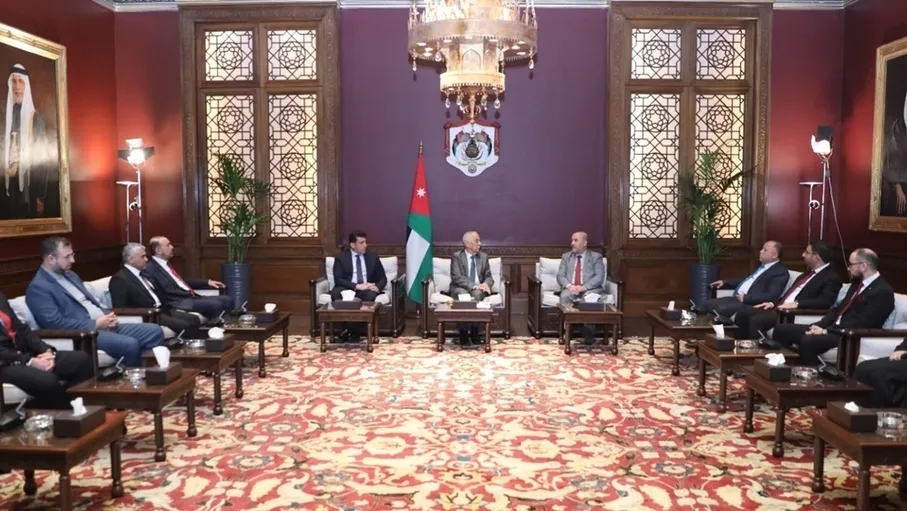الجيل الافتراضي .. محاولة فهم

"الأولاد بحاجة إلى نماذج أكثر منهم إلى نُقّاد" – جوبير
أتساءل، من هو هذا الإنسان الذي يقطن معنا في المنزل نفسه، ولا نراه، ولا نسمع صوته إلا عندما ينفصل النت في المنزل، عيناه مغروستان في جهازه الخلوي أو لوح ذكي أو شاشة كمبيوتر، وإذا أراد أن يمارس طفولته باللعب، فسيلعب على (البلي ستيشن أون لاين)؟
هو ينتمي لجيل آخر يسمى جيل (Z) أو ياء، جيل ما بعد جيل الألفية الذي سيرث الأرض ويحل مشاكلها وكأنه تجسيد لنبوءة تليدة، هذا الجيل الذي ولد في نهاية الألفية الماضية وبداية الألفية الحالية.
هم أول جيل لا يعرف الحياة قبل الهواتف الذكية أو الانترنت، ولدوا أيام فيسبوك وأبل، في وقت انقلبت فيه مفاهيم عديدة كالخصوصية والعلاقات الإنسانية والمعلوماتية والرقابة.
نخاف عليهم ونخشى أن يعيشوا حياة أصعب من حياتنا، فكُلف الحياة في ارتفاع والتنافسية شديدة والفرص أقل، وخوفنا هذا في محله، فهو جيل في منافسة على الوظائف مع التكنولوجيا، فثلث الوظائف ستختفي بحلول نصف هذا القرن و90 % منهم لن يستقروا في وظيفة واحدة.
كيف سيكونون بعد أن عاشوا في سنوات ما يسمى بمحاربة الإرهاب، وتصدرت حوادث الطعن والدهس الأخبار في عواصم العالم، وموجة الإسلاموفوبيا المتصاعدة، وبعد أن شاهدوا الدواعش يقطعون الرؤوس والقتل والاضطهاد والسبي باسم الرب، وصعود الشعبوية، والربيع العربي.
بعضهم خرج من أرحام الدواعش، وآخرون خرجوا من تحت أنقاض حلب والموصل، وبعضهم شاهدوا أقرانهم يقضون بالكوليرا أو برصاصة جبانة من قناص صهيوني.
لا شك أن حياتهم ستكون أطول من حياتنا، سيعيشون في حرية أكثر منا، وربما سينعمون بقدر من الديمقراطية أكثر منا، ستتأثر خياراتهم بآثارها على البيئة وعلى المجتمع العالمي، سيتوفر لهم تعليم أفضل منا، سيسافرون ويضحكون ويتذكرون مع آلاف من أصدقائهم، وبكبسة زر ستتوفر لديهم فرص غير محدودة.
نتساءل، هل سيكونون أكثر سعادة منا؟ هل سيكونون فريسة جاهزة للكآبة والتوتر المفرط؟ هل سيضيعون في ومضات الحروف أو داخل دارات حواسيبهم؟ هل سيكونون أكثر تسامحا وذكاء منا؟ هل ستوفر لهم التكنولوجيا الثقة والشفقة والاهتمام بالآخرين؟
لدينا آلاف الأسئلة عن أبنائنا، أبناء العالم الافتراضي!
قامت مؤسسة فاركي بتكليف مؤسسة بوبيولس البريطانية للدراسات للبحث في قيم وآمال وتوجهات جيل الألفية ومحاولة فهمهم، فأجرت المؤسسة استطلاعا شمل عشرين ألفا في عشرين دولة، وكانت نتائج الدراسة مهمة لفهمنا لأبنائنا.
فثلثي الجيل سعداء، وكلما كانت الدولة أفقر كانت السعادة أكثر، 97 % منهم لا يهتمون بالشهرة، وقلة منهم يمارسون الرياضة بمعناها التقليدي، وثلثهم فقط يشعرون بسعادة عاطفية، ونصفهم يؤمنون بحرية التعبير و60 % راضون عن الحياة في بلدانهم.
يرون أن حكوماتهم لا تفعل شيئا لمعالجة مشاكلهم، ولا يشغلهم الساسة، فاهتمامهم ببرنامج «واقعي» يفوق كثيرا ما يحدث في العالم، يرون أنفسهم مواطنين عالميين ولكن عندما يعبرون عن وطنيتهم أو أيديولوجيتهم يكون ذلك بشكل متطرف.
هم ضد العنصرية، أكثر استيعابا للمهاجرين، يؤمنون أن التكنولوجيا ستساعدهم في حياتهم، أكثر ما يقلقهم المال ثم الدراسة ثم الصحة ثم العائلة، وما زالت العائلة هي أهم أولياتهم ثم يليها العمل، مشاعرهم جياشة ومعقدة رغم أنهم قد يعطون انطباعا خاطئا بالبلادة.
هم أكثر تقبلا من الأكبر سنّا لقضايا زواج المثليين والإجهاض والمتحولين جنسيا والمساواة الكاملة بين الجنسين، أقل تدينا و42 % منهم يرون أن الدين مهم في حياتهم و17 % فقط يهتمون بالدين عند اختيار الأصدقاء.
ومن الأرقام التي صدمتني أن 89 % يرون آباءهم الأكثر تأثيرا فيهم، ثم أصدقاءهم بنسبة 78 %، ثم مدرسيهم بنسبة 70 %، و30 % من تأثرهم يعود للمشاهير و17 % للسياسيين.
إذن ما زال الدور الأكبر في صقل شخصيات أبنائنا وتحضيرهم للمستقبل منوط بنا، وما زلنا القدوات الأولى لهم.
صحيح أن هذا الجيل لا يحدّثنا كثيرا، ولكن يجب أن نتنبّه إلى أنه ما زال يتعلم منا، فلنهيئ جيل صلاح الدين مرة أخرى فالوقت لم يفت بعد.