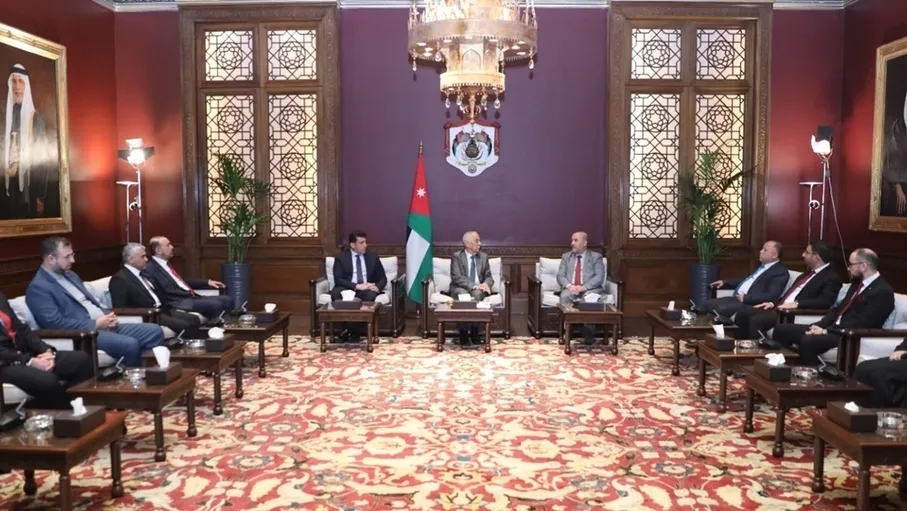مستقبل النظم السياسية بعد الربيع العربي: درس نصح من الربيع الأوروبي

بقلم : ا.د. محمد الحموري
كانت الثورة الفرنسية الأولى، العام 1789، ثورة دموية؛ غاب في قيامها بالقتل والسحل، منطق العقل، كما غاب القانون. وقد ضاق ميدان الثورة على اتساعه (ميدان الكونكورد الآن)، بتزاحم الجماجم التي فصلتها المقاصل عن أجساد أصحابها، ومنهم رأس الملك لويس السادس عشر، كبير عائلة البوربون المالكة، ورأس زوجته ماري أنطوانيت، أصغر بنات ماريا تيريزا إمبراطورة النمسا، هذا فضلاً عن الجثث التي اعتبر الثائرون أن تركها تتراكم في الشوارع والأزقّة وساحات الكنائس، يشكل ثأراً من أصحاب المقامات الرفيعة ورموز الحكم.
وقد تحالفت الأسر المالكة في أوروبا لإنقاذ لويس السادس عشر وزوجته من المقصلة، في أعقاب القبض عليهما، وقاد هذا التحالف أنسباء أسرة البوربون وأقاربهم المنتشرين على مساحة القارة. فماريا تيريزا؛ إمبراطورة النمسا، وهي سليلة عائلة هابسبيرغ ووالدة ماري انطوانيت، كانت قد أنجبت 11 بنتاً و5 أبناء، وزوجت البنات إلى أمراء وأولياء عهد، والأولاد إلى أميرات ووليات عهد، لتصبح أم الملوك والملكات في أوروبا. واستنفر من تولى المُلك من أبنائها في النمسا أصهاره وأنسباءه من ملوك وملكات القارة، وحركت حمية الدم ونخوة القربى أبناء العمومة من أسرة البوربون الحاكمة في إسبانيا، لتخليص الملك السجين وزوجته. لكن مرافعة روبسبير في محاكمة لويس أمام الجمعية الوطنية، أدت إلى الحكم بإعدام السجين في جلسة واحدة. إذ تم تصديق الحكم في اليوم التالي، ليقاد لويس إلى "الكونكورد"، حيث هوت على عنقه المقصلة، وأضيف رأسه إلى الجماجم التي تنتظر رئيسها هناك. بعد ذلك، يصدر الحكم على الجميلة ماري أنطوانيت في جلسة واحدة بالإعدام، لتؤخذ مباشرة إلى مقصلة الكونكورد، ويضاف رأسها إلى رؤوس أصحاب المقام الرفيع.
شعر أبناء فرنسا أنهم كسروا حواجز الخوف وقيوده إلى غير رجعة، وأصبحوا يتفاخرون على شعوب الأرض بإعلانات الحقوق ورفع رايات حرية الإنسان في العالم. وبهذه الروحية التي سيطرت على أبناء فرنسا، انطلق بهم الكورسيكي الأصل نابليون بونابرت -والذي اختطف الثورة من يد أهل السياسة المتصارعين على الحكم كأولوية على ما عداها عندهم- ليجتاح أوروبا، ولتتساقط، من ثم، الدول والممالك أمامه واحدة بعد أخرى. وما إن أنهكت الحروب نابليون وتعاظمت خسائر جيشه، حتى تمكن تحالف الأسر المالكة من الدخول في معركة النهاية مع نابليون، واحتلال باريس، وإعادة أسرة البوربون إلى حكم فرنسا في 4 نيسان (أبريل) 1814؛ بدءاً بلويس الثامن عشر شقيق لويس السادس عشر الذي أعدمته الثورة الفرنسية.
ومن أجل إغراء أبناء فرنسا، الذين كانوا قد كسروا حواجز الخوف بثورتهم الدامية العام 1789، بقبول عودة أسرة البوربون إلى الحكم، وافق ملوك أوروبا من الأنسباء والأصهار وأبناء العمومة، على أن تصبح فرنسا ملكية دستورية على غرار بريطانيا، وفقاً لميثاق فينّا العام 1814، وقبل الملك الجديد بذلك. لكن الطبْع كان غلاباً عند أبناء البوربون؛ إذ تدريجياً، أصبحوا يمارسون الحكم المطلق من الناحية الفعلية. فصادروا حرية الصحافة والتعبير وحق التظاهر، وغابت المساءلة والمحاسبة، وأخذ الأمن يشدد قبضته على رقاب الناس، وتم تقسيم الناس إلى موالين لهم جميع الامتيازات، وغير موالين ينبغي حرمانهم ليعودوا إلى رشد الموالاة. كما انتشرت المحسوبية وساد الفساد.
ونسي ملوك البوربون أنهم أمام شعب أصبح لديه التحرّر من الخوف قيمة اجتماعية ونفسية تعيش في العقول والوجدان، وأن صمت الناس لم يكن خوفاً، وإنما للإمهال وإعطاء الفرصة. ومن ثم، تفجرت ثورة فرنسا الثانية، العام 1830، ليهرب الملك، الشقيق الثالث للمعدوم، وتهتز كراسي الحكام المهووسين بالسلطة في أوروبا مرة أخرى تحت أصحابها؛ فيرعوي البعض، ويستمر البعض الآخر في غيّه من دون أن يدرك أن ذلك إلى حين. وعندما عاد من نصبه ثوار فرنسا العام 1830 ملكاً، إلى نهج أقاربه وتجبر، وانتشر الفساد والإفساد وخنق الحريات مرة أخرى، قام الفرنسيون بثورتهم الثالثة التي بدأت في 22 شباط (فبراير) 1848.
لكن أشباح الدماء وأكوام الرؤوس التي تراءت لأبناء فرنسا عن الثورة التي غاب فيها العقل العام 1789، كانت درساً ترسّخت قسوته في ذاكرة الفرنسيين ووجدانهم. وهكذا، كانت ثورتهم الثالثة ثورة عاقلة تجنبت الدم. وساعد على ذلك أنه عندما تخلى النصاح والبطانات عن الملك لويس فيليب؛ آخر ملوك البوربون، هرب متخفياًَ الى بريطانيا، حرصاً على رأسه حتى لا تهوي المقصلة على عنقه، كما حدث مع ابن عمومته في الثورة الأولى. ومع هروب الملك، أعلنت قيادات الثوار الجمهورية الثانية في 24 شباط (فبراير) 1848، من أحد الفنادق التي تجمعوا فيها (Hotel de Ville). ومن المفارقات الملفتة أن بطانات الملك، وأصحاب المقام الرفيع الذين كانوا يحيطون به، سارعوا إلى الانضمام للثوار حتى قبل هروب ملكهم؛ فما كان منه إلا أن وصفهم عند وصوله إلى الشاطئ الإنجليزي: "إن ولاءهم لي كان تكسباً وتجارة رابحة، وليتهم تعلموا من كلبي الذي كانوا ينحنون له، بعض قيم الوفاء".
هكذا، بدأ الربيع الأوروبي اعتباراً من تاريخ انتصار الثوار وإعلان الجمهورية الفرنسية الثانية. فخلال شهر آذار (مارس) 1848، زحف الربيع الأوروبي بذات النهج الثوري الفرنسي إلى كل من هنغاريا، ومناطق الراين الألمانية، وفيّنا في النمسا، وبرلين في ألمانيا، وميلان في إيطاليا، وفرانكفورت في ألمانيا؛ ثم امتد إلى التشيك، وسلوفاكيا، وهنغاريا، وكرواتيا، ورومانيا، حتى غطت اندفاعة الشعوب المطالبة بحقوقها باقي دول أوروبا وإماراتها ودوقيّاتها، ووصل إلى الدويلات التي يمارس عليها البابا سلطة سياسية في إيطاليا. وكانت أهداف شعوب تلك الثورات واحدة، وهي استرداد حقوقها وحرياتها، والمشاركة في القرار الذي يحكمها وفقاً لتمثيل يجسد إرادتها، والتخلص من الحكم الظالم والفاسد الذي ران على قلوب أبناء أوروبا قروناً عدداً. وفي بعض الدول، تقدمت المطالب خطوات وخطوات. ففي ألمانيا وإيطاليا، أصبحت المطالبة أن تتحقق وحدة الأمة، والتخلص من العوائل التي اجتزأت كل منها لنفسها من جسد الأمة وأرضها إمارة تتوارث حكمها. وانحنت بعض الأسر التي تتوارث السلطة أمام شعوبها، وقاوم البعض الآخر، مستخدماً ضد شعبه جبروت الأمن وسجونه، استهداء بنصائح بطانات كانت كالطحالب لا تستطيع العيش إلا في مستنقعات الحكم المطلق.
الغريب أن نصائح تلك البطانات الطحالبية لسيدها الأمير أو الملك، كانت متماثلة: المتمردون قلّة، وباقي الشعب معك؛ الانحناء والتنازل يشجعان على المطالبة بالمزيد؛ حب الشعب لك يختلف عن حب الشعوب الأخرى لحكامها؛ الوعود كفيلة بامتصاص انفعالات الناس... إلى غير ذلك من نصائح التغرير والإغواء. وكانت محصلة تلك النصائح أنه خلال العقود اللاحقة، أدى كسر الشعوب لحاجز الخوف إلى زوال أسر الممالك والإمارات التي عاندت شعوبها، واستمرار تلك انحنت واستجابت لإرادة الشعب، ولتبدأ البشرية طوراً جديداً من أطوار تطور النظم السياسية والدستورية.
ذلك أنه عندما انطلقت الثورة الفرنسية الثالثة في 22 شباط (فبراير) 1848، كان عدد الأسر المالكة التي تتوارث حكم دول وإمارات في أوروبا، 50 أسرة. لكن ربيع أوروبا أزال من التاريخ 41 منها. ومن الغرائب التي حدثت لهذه الأسر التي طواها التاريخ، ما جرى لأسرة هابسبيرغ التي توارثت الملك على مدى 642 سنة. إذ أصدر النمساويون بعد ثورتهم على هذه الأسرة، قانوناً يطردهم من البلاد ويمنعهم من دخولها. لكن بروز موضوع حقوق الإنسان في أوروبا الموحدة خلال النصف الثاني من القرن العشرين، أدى إلى تعديل هذا القانون، والسماح بإمكانية عودة أبناء هذه الأسرة إلى النمسا. واستمر وجه الغرابة قائماً عندما رفع كبير عائلة هابسبيرغ التي عادت إلى النمسا، دعوة أمام القضاء في العام 2009، يطالب فيها بتمكينه هو وأبناء أسرته من حقوقهم السياسية، والسماح لهم بالترشح في الانتخابات البرلمانية. وذات الأمر حدث في ألمانيا مع أسرة هوهنزوليرن التي توارث أبناؤها الحكم على مدى 1075 سنة، رغم أنها وحدت ألمانيا عندما كان بسمارك رئيساً لوزرائها العام 1871. ولاحقاً أسرة سافوي ذات الـ943 سنة من توارث الحكم، وأنجزت توحيد إيطاليا، العام 1861، في الدولة التي نراها الآن.
أما الأسر الأوروبية المالكة التي استمرت في الحكم؛ وهي تسع، فتتكون من سبع ملكيات وإمارتين. وقد أدركت هذه الأسر، بفضل حكمة نصاحها، أثر كسر الشعوب لحاجز الخوف على حركة التاريخ، والكيفية التي يعمل بها القانون الحتمي لبقاء النظم الحاكمة واستمرارها، أو زوالها عند الشعوب. ومن ثم، فقد انحنت هذه الأسر واستجابت لإرادة شعوبها، وقبلت أن تفصل بين الملك المتوارث من غير سلطة، والسلطة التي أصبحت حقاً خالصاً للشعب وحده. فكافأتها تلك الشعوب بأن احتضنتها وقدّرتها، وجعلتها رمزاً لها، وحمتْها من تقلبات الدهور وعاديات الزمان. فعائلة أورانج الهولندية، ما تزال تتوارث المُلك منذ العام 1559؛ وعائلة خوان كارلوس من آل البوربون (فرع إسبانيا) ما يزال أبناؤها يتوارثون الملك منذ العام 1700؛ وعائلة الملكة اليزابيث في بريطانيا، ما تزال مستمرة منذ أن تم استحضار جدها الألماني جورج الأول من هانوفر العام 1714، ليصبح ملكاً على بريطانيا، وتبدأ به أسرة هانوفر. وكذلك أمر عائلة ساكس كوبورغ الألمانية الأصل، فما تزال تحكم بلجيكا منذ العام 1831.
أما بالنسبة للربيع العربي الذي بدأ أوائل العام 2011، فما نزال نعيش معطياته، لكن كثيرا من أهل الحكم ومن يحيط بهم من بطانات وساسة ورجال أمن، لم يدركوا بعد حتمية حركة التاريخ القادمة، والتي وفّر لها كسر حاجز الخوف، متطلب الاندفاع؛ وأن الأمة العربية قد دخلت في طور جديد من أطوار التاريخ، هو الآن في مرحلة التكوين، ولم تتوافر لأبنائها معطياته من قبل. وسوف يتكامل هذا الطور ويفرض نفسه، ويزيل من يقف في وجه حركته.
فعلى مدى تاريخنا حتى العام 2011، لم يحدث أن خرجت عندنا جموع بشرية إلى الشارع تطالب بإسقاط حاكم أو إصلاح حكم. إذ خلال العهد الراشدي، لم يكن الناس بحاجة إلى الخروج، فقد كان حاكمهم يطلب منهم تقويمه إن وجدوا فيه اعوجاجاً. ومنذ عهد معاوية بن أبي سفيان وحتى العام 2011، كان خوف الناس وما تم بثه في نفوسهم من رعب، يمنعهم من الخروج؛ يستوي في ذلك الخوف والرعب من سوط السلطان وسجونه، أو من فقهاء السلطان الذين يشكلون شرطته السماوية، عندما يتوعدون الناس بالنار وعذاب السعير في الآخرة، لمن يجأر من ظلم سلطانه وفساده. لكن هذه المرحلة من مراحل التاريخ قد انطوت وإلى غير رجعة.
هكذا أصبح انطلاق الربيع العربي في العام 2011، حدثاً تاريخياً جديداً وغير مسبوق في حياة الأمة؛ من حيث الأسلوب والمضمون في آن معاً، تماماً كما حدث في "الربيع الأوروبي". فخلال الأشهر الأولى من بداية الربيع العربي، اجتاحت عاصفة المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات، حدود الدول من غير استئذان حراسها، مطالبة إما بإسقاط أنظمة الحكم أو إصلاحها، في عديد من دول العالم العربي التي كسرت شعوبها حاجز الخوف، وأودت برئاسات أربع دول عربية، كانت كل رئاسة فيها تعتقد أن قبضة أجهزتها الأمنية والاستخبارية على الأعناق والأرزاق، كفيلة بإسكات الناس واستمرار حبس شكواهم وآلامهم في دواخل نفوسهم.
وإذا كانت السنوات الثلاث التي اكتملت من عمر "الربيع العربي" قد شهدت عدم استقرار الحكم في دول الثورات الأربع التي طوت صفحة حكامها، فذلك أمر طبيعي ومألوف في مصاحبته للثورات. إذ لم يحدث في التاريخ السياسي والدستوري، أن استقر حكم في أعقاب ثورة، بين عشية وضحاها؛ فالاستقرار يتطلب مرور بعده الزمني الذي يحتاجه الصراع على الحكم بين التوجهات المتباينة. ولذلك، فإنه إذا كان عدم استقرار الحكم في دول الثورات الأربع قد أدى إلى هدوء نسبي لدى شعوب الدول الأخرى، فإن ذلك لا يعدو أن يكون كموناً لأنفس كسرت حاجز الخوف، تستجمع ذاتها وتنتظر، للانطلاق مع أي شرارة؛ إذ هي كالجمر تحت الرماد، لا تستطيع الأعين التي تجردت عن بصيرتها أن تدركه أو تراه، ودروس التاريخ تعلمنا أنه لم يحدث أن عاد مارد الشعوب إلى قمقمه بعد انطلاقه.
لست أدري كيف تفكر البطانات وحلقات الحكم، وإلى أين هي ذاهبة بشعوب الأمة وحكامها؟ هل يسيطر على تلك البطانات والحلقات معطيات اللحظة، وتستخلص من كمون الناس انتصاراً عليهم تتفاخر بإنجازه، فتنسى أو تتناسى مطالبهم بالإصلاح؟! أكاد أقطع بأن أولئك القوم لا يدركون أبعاد الطور التاريخي الذي نعيشه، ولا متطلباته، ولا القانون الحتمي الذي يحكم النظم السياسية، عندما توفّر المستجدات ورسوخها لدى شعوب تلك النظم، متطلبات عمل هذا القانون.
إنني أنادي بأعلى الصوت وأقول: إن ما حدث العام 2011، كان موجة أولى تنادي بالإصلاح. لكن الموجة التالية ستكون عاتية، وقد تؤدي مناداتها بالتغييرات الجذرية إلى صدامات وسيل دماء؛ فتجنبوها بإصلاح حقيقي، لأن الدماء عزيزة غالية، ولو سالت فسوف يتبعها الطوفان.