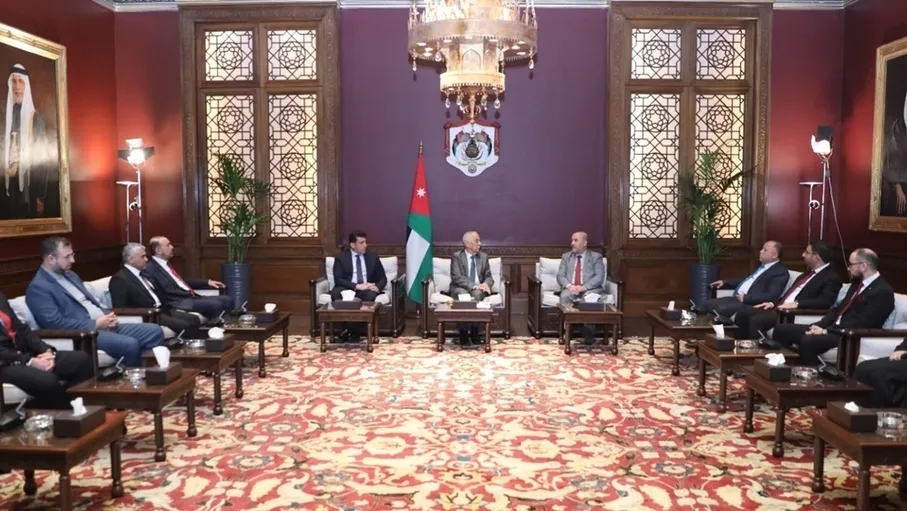ابتزاز مغلف بالقهر

في العقبة، يصر عمال ميناء الحاويات على مواصلة الإضراب، مكبّدين الاقتصاد الوطني خسائر تقترب من نصف مليون دينار يوميا.
كل محاولات إقناع هؤلاء العمال بعدم الإضرار بالبلد تبوء بالفشل؛ فتراهم يلجأون، من حين لآخر، إلى ليّ ذراع الجهات المسؤولة، نتيجة إدراك عميق للأهمية الاستراتيجية للميناء لدى مختلف القطاعات الاقتصادية.
التعاطف مع المضربين هو حق وواجب، لو كانت ظروفهم المالية ورواتبهم غير عادلة. بيد أن الأرقام التي تعلنها الجهات الحكومية تؤكد عكس ذلك؛ إذ ترتفع أجورهم بنسبة 99 % عن المتوسط العام للأجور في الأردن!
وقد كانت شركة مناجم الفوسفات شهدت، بدورها، اعتصامات عمالية كثيرة، أثّرت بشكل كبير على نتائج الشركة المالية؛ إذ أوقعت بها خسائر ما تزال تدفع ثمنها حتى اليوم.
الإضرابات بعد كل المنافع التي تحققت في قطاعات مختلفة، باتت آلية ابتزاز للمؤسسات، لتحصيل مكتسبات أعلى، وإن كان المتضرر الأكبر، على المدى المتوسط ناهيك عن المدى البعيد، هم العاملون أنفسهم! وذلك بسبب الضرر الذي يلحق غالباً، إن لم يكن دائماً، بالمركز المالي للشركات والمؤسسات.
أشكال الاستقواء العمالية والشعبية مختلفة ومتعددة، ومنها أيضا رفض أصحاب بسطات قرارَ أمانة عمان بنقل سوق الجمعة من منطقة العبدلي إلى راس العين.
وقد أخطأت "الأمانة" بعدم التمهيد للموضوع، وبحثه مع أصحاب العلاقة، وتقديم مبررات قرارها لكل طرف معني بالقصة.
لكن أصحاب البسطات أخطأوا بدورهم برفض تنفيذ القرار، بل والدخول في مواجهة أدت إلى وقوع إصابات بينهم كما بين رجال الأمن.
المشكلة أن الإضرابات في الفترة الحالية تأتي في ظروف شدة وضيق لا استرخاء، في خضم أزمة سياسية وأمنية واقتصادية إقليمية، ذات آثار عميقة محلياً. وبروز هذه المشكلة الآن تحديدا، ينطوي على خطورة أشد؛ لما تفضي إليه من تبعات مالية سلبية على المؤسسات المعنية.
"موضة" الإضرابات العمالية والحراك المطلبي، بدأت منذ نحو ثلاث سنوات، وتزامنت في معظمها مع الحراك المطالب بالإصلاح السياسي. وقد تفاقمت هذه الظاهرة/ الموضة حد أنْ بتنا نشهد في أسبوع واحد، أحياناً، عشرات الاعتصامات والإضرابات، وبما خلق جوا عاما غير مريح، إزاء مشهد لم يكن بريئا، ويقرأ في أكثر من اتجاه.
وسيبقى الشعور بإمكانية ممارسة هذا الاستقواء واردا، طالما غابت خطط الحكومة الشاملة لاستعادة هيبة الدولة، وهي التي بدأتها فعلاً بشأن الاعتداءات على المياه والكهرباء خصوصاً. تماماً كما ستبقى القدرة على ممارسة مزيد من الابتزاز قائمة، طالما ظل غائبا الشعور بالمواطنة والانتماء وتحقيق العدالة في الحقوق والواجبات.
ويندرج تحت ذلك ضعف الإحساس بالمشاركة في القرار، وشعور بالعداء لدى البعض، يحتاج إلى تفسير، تجاه المؤسسات العامة والحكومية، وإن من الممكن استنتاج أحد أسبابه (العداء) في فشل هذه الأخيرة الذريع في خلق فرص في سوق العمل، تؤمّن للفرد عيشا كريما، كما تكريس مبدأ التنمية الشاملة التي تنعكس على حياة المواطن عموما.
المجتمع لم يتعافَ من شعور عدم الرضا؛ بل إن أجواء الاحتقان في ازدياد. والأمر يتعلق بتركة مرحلة سابقة لم تخفف منها الحكومة الحالية، بل زادتها بقراراتها الصعبة معيشيا، لاسيما أن هذه القرارات لم تتزامن مع تسريع تنفيذ خطط تنموية تنتشل المواطنين من شعور القهر قبل فاقة الفقر.