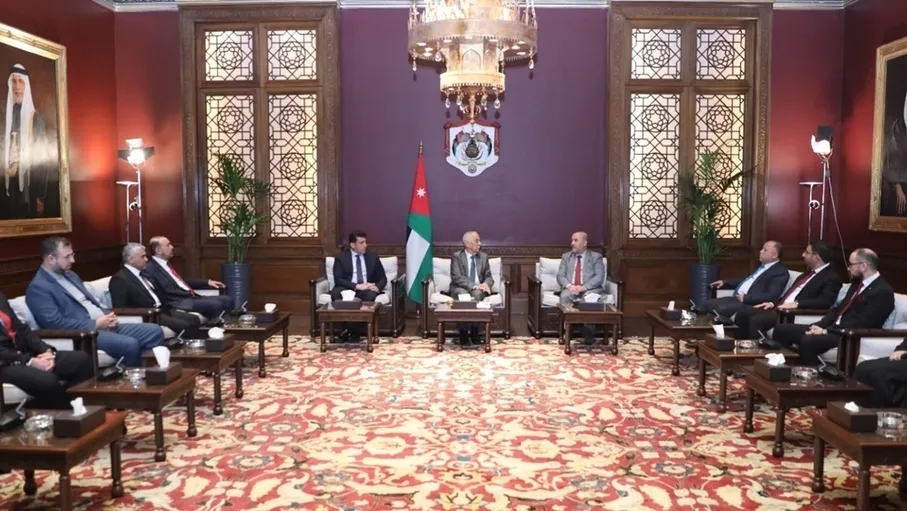ضحكة النصر

لَم يَجفل في اللحظة التي شَقّت لحمه الرصاصة، كان يراها وهي تُواصل مسيرها نحو عظام الرأس، كان يواصل الإبتسام وهو يراها بعينه التي أفلتت من رأسه، واستقرت على جناح فراشة من سرب فراشات بيضاء كانت تنتظر الزهرات التي ستُنجبها قَطرات دمه.
كانت إبتسامته تتسّع أكثر، كلما هطل الدم بغزارة أكثر من غيمة شوقه للتحليق على تلك الأجنحة البيضاء، التي تسابقت لتحمله نحو السهوب المفروشة بزهر الزعفران الذهبيّ ألموشّى بلون البرتقال الذي عاد ليستأنف الإزهار لحظة رائحة دمه الزكية طَغَت على شذى عطر البُرتقال.
كان نُحاس الرصاصة يخجل من أن يُفتّت العظم، لكن عظمه خَطَفَ من ابتسامته قبولا، ورضى ليُبدي لنحاس الطلقة تَرحيبا يستعجل فيه نعسَ الموت الجميل، المُحبّب الذي لا يَخشاه مثله، من أسقط روحه على راحة كَفّه اليُمنى لتلتقطها طيور أمّت المكان لتُواكب الأجنحة البيضاء التي لم تَمَل الإنتظار حتى لو طال أمَدَه. في تلك اللحظات التي سَبَقَت ذُبول أجفانه، كان حلقه، وشفتاه المُبتسمتان يُردّدون كلمة الله، ثم الله، فالله، وبين كل نُطقٍ، ونُطق كانت عينه تجول فوق سهوب الوطن تارة، وتارة وفوق وَجنات طفلته الوحيدة، بعدها أطلق ضحكة النصر، ثم حَلّق.
إنه شهيد الوطن «راشد الزيود».