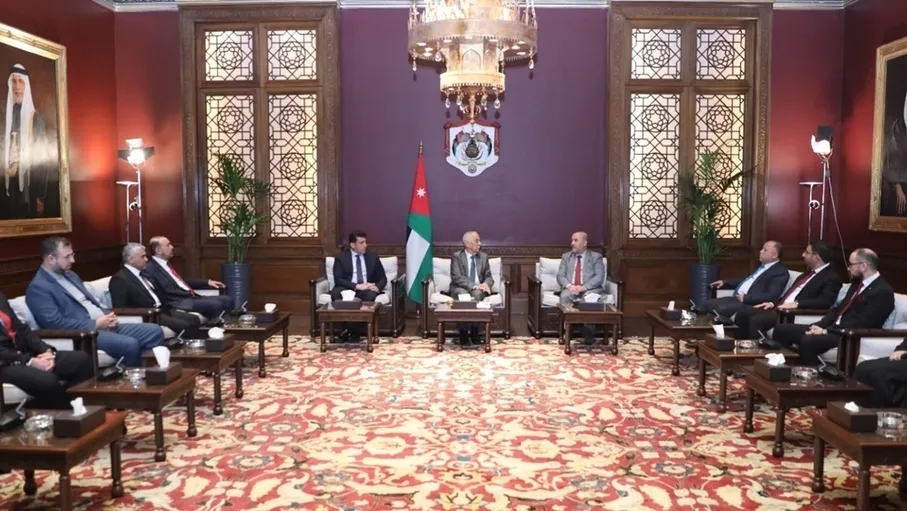حلوة

لا يخلو الأمر من قصص حب في حياة الفتى الذي يمسك بياقة قميصه المشجر، وهو يركض نحو أحلام معلقة في سقف السماء، لا يطالها حتى الجن.
وها مساءاته المدهونة بزيت القناديل، لا تخلو من لفتة رشيقة لظبي يسرِّح شعر الحقول، أو حجل يتخفى ببطن الجبل، هناك، حيث رأى الريش أول مرة، ريش الحمام والعصافير المتجهمة على أشجار الخوخ والدراق في المحطة الزراعية بمخيم البقعة.
كان يراقب حراس المحطة، وهو يحاول أن يفتح في أسلاك السياج الشائكة، كوة يمرر عبرها جسده على حين غرة من الحراس، ثم ينسل لاختطاف حصته من ثمار أشجار المحطة، فيمرق منها كالسهم، ينتزع حبة دراق، أو خوخ، ويعود منتصرا للبراكية.
هو الحب إذن، لا كما ينبغي للسهل أن يتخيل، ولا لعباد الشمس أن يميل بقرصه البارخ في أوراقه الصفراء، حيث ينتصب متهدلا، لا، هو حب مشحون بهدأة القلب واستكانتها لرغبة الفتى في أن يحلق ولو قليلا فوق الريح.
هو، أكثر من حب، ربما، وأقل من تحليق، فيما "حلوة"، تفتح ذراعيها الكبيرين، لتهرس أضلاعه وهو يتقدم منها، مزهوا ببراعته في قراءة كتاب جديد، أثمله حتى الفجر.
لم تكن تعرف منه إلا أنه ابن ابنها، وبكره. ويا لها وهي تتحسس أعلى شفته السفلى، تبحث عن نتوءات شعر غليظ تنبت عليها، فالفتى أصبح حصانا، بصوت أجش.
ويا لها، وهي تدس يدها بين طيات الفراش المرصوص على مسند خشبي قديم، كانت تخرج له منها قطع الحلوى، والفاكهة وبعض القمصان التي انتقتها من جارها بائع الملابس المستعملة لأجله.
لا أعرف لم تهب "حلوة" برائحة اللوز والعشب الآن علي. ليس من مناسبة بعينها هي من تطلق هذا الهبوب، إنها تهب بعيدا عن زاوية الحنين المرهقة، ولست أرغب بأكثر من عناقها الدافئ، ومن ثم، وهي تمسك بيدي لتقودني إلى شجرة الخوخ في حاكورتها الصغيرة، لتريني ثمراتها المخضوضرة.
أي بداهة تلك التي كانت "حلوة" عليها، وهي تعلمني كيف أعشق النبات، وأهذب علاقتي مع الطيور، وأنتقي مفرداتي حين أتحدث مع أحد؟
ويا لها من باذخة، وهي تفتح صندوق الحكايات لتلقي علي كل مساء حكاية، تتفتح في رحابها مخيلة الفتى على فضاءات لا حدود لها من الأحلام والتوقعات.
كنت أتسمر في بهاء سردها العميق، أتساءل عما يجعل هذه الجدة الكبيرة، سيدة للرحابة والكلمات. ذاك بذخ بت أحلم بأن أصغي له بعد ان رحلت عني أمهات عديدات، كن يلاحقنني بدعواتهن المعطرة بالحب والسلام، وأنا أحمل حقيبتي المدرسية، لاهثا وراء الكتب والقيظ، وينسجن لي كنزات الشوق دفقات القلب.
أتذكرها الآن، كما لو أنها تحوم مثل طيف سماوي، يحتدم فيه الطهر والندى، فيستيقظ الفجر، كانت تلملم الفتى القادم من عمان، ليريح أحلامه في برية المخيم المنهكة، بالصفيح والخذلان الأبدي.
تلك "حلوة"، جدتي، المرأة التي كانت تحمل اسمها بهدوء وهي تشذب تينة البيت، وترش عليّ السكر حين ألقي برحالي في براكيتها، مستنجدا برحابتها من ضيق بيتي الواسع.
أتذكرها الآن، لأنني ما زلت عصيا على التوقف أمام أي سنديانة لا تبعث رائحتها على التعلق بجدائل الضوء، وأغاني العشاق، وخرافات الجن والسحرة المهزومين ببطولات الشعراء.
ياه، يا "حلوة"، كم أشتاق لاستهلال صغير من استهلالات حكاياتك البرية، وهي تجعل من قصص الحب، فتنته التي ما يزال معلقا بها إلى اليوم.