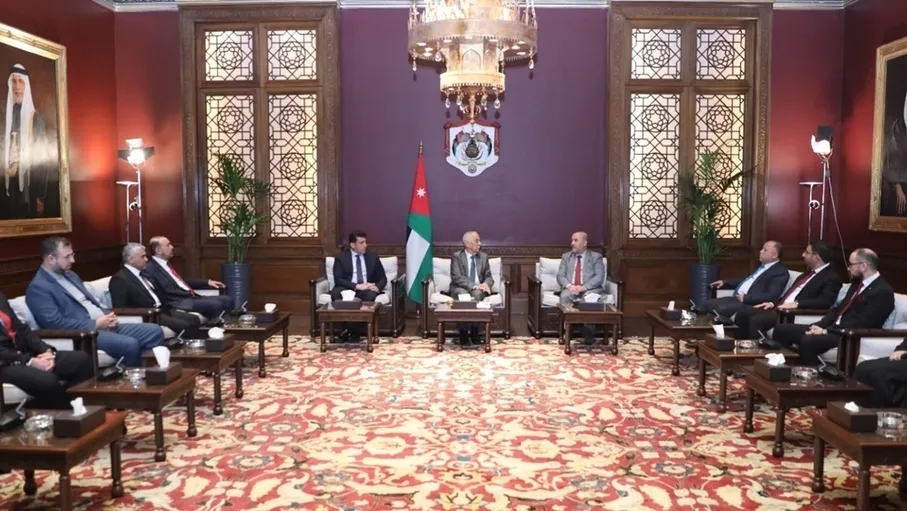المنهاج والمعلّم.. علاقة مشتبكة!

في مساق في النقد الأدبي، قالت أستاذة الأدب، في تمهيدها لنظرية التحليل النفسي في النقد: "فرويد مجنون". وقالت، بالجملة، إن "داروين مجنون" أيضاً. وأوضحت بتهكم: "فرويد يقول إن الولد يشتهي أمه، وداروين يقول إن أصل الإنسان قرد". وسألت: "أليس كذلك"؟ وهز الطلبة رؤوسهم مُؤمِّنين. ولأنها تعرف عن مشاكستي الموسمية، سألتني عن رأيي. قلت إنني أتصور -مع آخرين- أن فرويد وداروين، وماركس صنعوا القرن العشرين.
لم تكن الأستاذة، حسب معرفتي بطريقتها، تقول ذلك عن داروين وفرويد من باب استدراج النقاش، وإنما قالته عن قناعة. والمشكلة أن الطلبة المعتادين شرب المعلومات بالملعقة، قبلوا بذلك -حقيقة أو تظاهراً. لكن الطالب الجامعي قد يكون أقدر في النهاية على بعض الاستنطاق -داخلياً على الأقل. فماذا عن تلميذ المدرسة الصغير في الصفوف الابتدائية أو الإعدادية؟ ولو تصورنا أننا ابتكرنا مناهج دراسية عبقرية تستجيب للحداثة والمنهج النقدي، هل سيساعدنا المعلمون على تجسيد المناهج؟
إذا قال المعلم لطلبته الصغار إن "فلانا" مجنون قبل أن يقرأوا الدرس عنه، أياً كان محتواه، فسيتعلمون أن "فلانا" مجنون، احتراماً للأستاذ وإيماناً به. وسوف يقاربون "فلاناً" هذا بعداء سلفاً. وقد يضم مساق محايد في التاريخ عرضاً معتدلاً للشيوعية مثلاً، كحاضر يجب المعرفة عنه في العالم. لكن المعلم ربما يبدأ درسه ببيان من نوع: "الشيوعيون كفار، ما عندهم أخلاق ولا يحللون ولا يحرمون". وقد يبدأ بشيء مشابه في درس عن دين آخر، أو عِرقٍ آخر. وفي النهاية، سيروج المعلّم نسخته من "الرؤية العالمية" الأحادية، ويفقِّس نسخاً بعدد معظم طلبته عن نفسِه المعتقدة بامتلاك الحقيقة.
ربما لا يكون الأمر هكذا بالضرورة، لكن بالوسع ترجيح هذا النمط لسبب موضوعي: أن شخصيتنا الاجتماعية بكيفياتها المتوقعة، من معلمين وغيرهم، هي نتاج لنفس المنهج التلقيني وجملة العصبيات و"القناعات" و"المسلمات" المفروضة. وإذا كان الاهتمام يتركز الآن على نقد العقلية السكونية التي أنتجتها الطرائق السائدة في التعليم، فإنه يجري التعويل على هذه العقلية المصنَّعة بهذه الكيفية نفسها لتحمل المشروع الجديد، إلى أن يتكون الجيل الذي تخلص من العقد السابقة. وإذا كنتَ لا يمكن أن تجني من الشوك العنب، فيجب أن تقلق.
المأزق الدائم في المشاريع التحويلية، هي أنها ينبغي أن تكسر دائرة شرسة وتنقطع عن مركزها ثم محيطها بدفع قوة طرد مركزي. لذلك، قد تستعين شركة متعثرة بمدير وطاقم إداري من مكان آخر، لأن أبناء المؤسسة يكونون متطبعين بفكر المؤسسة وسلوكها. لكنّ هذا الاقتراح غير عملي في التعليم (ربما باستثناء إمكانية استبدال الذين يخططون بآخرين أكثر انسجاماً مع المشروع). أما المعلمون، المعنيون هم أخيراً بتطبيق الرؤية وصناعة الفارق النهائي، فمسألة تستوجب الكثير من حك الدماغ، خاصة في بلد لا يستورد المعلمين.
يفترض في الذي يريد أن يصنع عقلاً نقدياً، أن يكون متمرساً في التفكير النقدي أولاً. وعلى سبيل المثال، يُحتمل أن يكون أستاذ الفلسفة -وهي أصل الجدل- أحد اثنين: إنه إما سيعلمها لطلبته على طريقة حفظ جدول الضرب، فيجردها من وظيفتها ومحتواها؛ أو أنه سيجعل المعلومة عربة فقط لاستدراج النقاش وطرح الأسئلة، والتدرب على المحاكمة المنطقية. وعلى الأغلب، سيكون الأستاذ -بأي من هاتين الكيفيتين- نتاجاً لأسلوب أساتذته -أو أنه سيكون قد أفلت بجهد ذاتي أو عوامل مساعدة من المسار الدائري بقوة طرد مركزي ما.
يصعب اقتراح وصفة لإحداث الاختراق المطلوب، والمسألة مطروحة لمداخلات العارفين. لكن إحدى الوسائل ربما تكون الإصرار حسَن النية من جهة مراكز صناعة القرار التي تملك المنبر وأدوات التأثير على الافتراق عن الطريق القديمة. وسيكون تكرار الفكرة، والمثابرة والمراجعة، بداية لإلقاء حجر في الماء الراكد. وعلى مستوى أكثر عملية، ينبغي استكمال إدخال منهجيات ومناهج جديدة في التعليم بدورات إجبارية مكثفة للمعلمين، مشروطة باجتياز اختبارات وبإشراف موجهين إيجابيين، لعل عملية الانتقال تبدأ من نقطة معقولة.
لا تقليل من شأن المعلمين في هذا التصور قطعاً. فنحن جميعاً نتاج لطريقة تصنيع العقل نفسها. وسوف تتدخل حتماً مؤثرات العقل الأسري، والعقل الاجتماعي والسياسي في إنجاح تطوير التعليم أو إفشاله. ولكن، يجب البدء من نقطة مكان في نهاية المطاف، ولا بديل عن مفاوضة مصاعب البدايات.